هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريم هو ملخّص الجلسة الأولى من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الأستاذ بناهيان في جلسات هيئة الشهداء المجهولين في طهران حيث خصص أبحاثه باستعراض تحليلي لتاريخ الإسلام، فانطلق في أبحاثه من أحداث التاريخ وظروفه ومنعطفاته إلى فهم زماننا المعاصر وما نعيشه من ظروف وواقع. وجدتها حرية بالترجمة والنشر فعمدت على ترجمتها مستعينا بالله وسائلا إياه التوفيق والتسديد.
نحن اليوم بحاجة إلى مرور تاريخ الإسلام أكثر من أي زمان آخر/ لا ينبغي أن نكتفي بمرتكزاتنا المشهورة عن تاريخ الإسلام
لقد أصبحنا في هذا الزمان بحاجة إلى تاريخ الإسلام أكثر من أي زمان آخر. حيث إن الظروف الراهنة التي نعيشها الآن تقتضي إدراكنا العميق للدين أكثر من الأزمنة الماضية. إن الكثير من الاختلافات في الآراء لم تعد ترتبط بأصل الدين وحقّانيته، بل بعض الاستنباطات السطحيّة من الدين هي التي تثير المشاكل.
إن مدى حاجتنا اليوم إلى تاريخ الإسلام أوسع من أن نكتفي ببعض القضايا المشهورة في التاريخ. فهناك الكثير من القضايا والتفاصيل القطعية والثابتة في تاريخ الإسلام ولكنها غير مشهورة وعادة ما لا تؤخذ بعين الاعتبار مع أنها نافعة جدا في رؤيتنا تجاه تاريخ الإسلام.
لابدّ لنا من دراسة تاريخ الإسلام بمزيد من الدقة وذلك من أجل الحصول على معرفة عميقة وصحيحة بأصل الدين. ثم إن المسائل التاريخية التي تمّ تناقلها جيلا بعد جيل واشتهرت على الألسن لم تكن المسائل الرئيسة في التاريخ بالضرورة كما ليس بالضرورة أن تكون هذه المشهورات متناسبة مع ما يقتضيه واقع مجتمعنا اليوم. لقد تطور مجتمعنا كثيرا وهذا ما يفرض علينا أن نراجع الزوايا الخفية في تاريخ الإسلام أكثر من قبل.
إن الاكتفاء بالقضايا التاريخية المشهورة قد يحرفنا عن الصواب في استنتاجنا من التاريخ، ولا شك في أن النتيجة الخاطئة التي نخرج بها من التاريخ قد تؤدي إلى عدم الصواب في فهم الإسلام بشكل عام.
فعلى سبيل المثال كان تحليل الشيخ بهجت(رض) عن قيام الإمام الحسين(ع) قائما على بعض الحقائق غير المشهورة في تاريخ الطفّ. فقد قال سماحته مستندا إلى الوثائق التاريخية: بعدما رأى الإمام الحسين(ع) عدم وجود الناصر، رضي بأن يكفّ عن محاربة يزيد والقيام ضدّ الحكومة كما فعل أخوه الإمام الحسن(ع) مع معاوية. فقد اقترح الإمام الحسين(ع) هذا الأمر على عمر بن سعد حينما التقى به في كربلاء، ولكن أبى ذلك عمر بن سعد حيث كان قد حصر الطرق على أبي عبد الله الحسين(ع) بين القتال أو الاستسلام؛ أي يستسلم له حتى يبعثه مكبلا إلى يزيد ويقرّر هو عند ذلك في أن يقتله أم يطلق سراحه. ولذلك قال الحسين(ع): «ألا! و إنّ الدّعیّ بن الدّعیّ قد رکز بین اثنتین: بین السّلّۀ والذّلّۀ، و هیهات منّا الذّلۀ، یأبی اللهُ لنا ذلک و رسوله والمؤمنون.»[اللهوف/ص97- الاحتجاج/ج2/ص300]
مضافا إلى «الاطلاع» على تاريخ الإسلام نحن بحاجة إلى «تحليله»/ إن لم يكن لدينا تحليل تجاه حدث اجتماعي فهذا يعني أننا لم نفهمه/ إن التاريخ أحد مصادر فهم الإسلام كالقرآن
مضافا إلى ضرورة التعرف على تاريخ الإسلام، هناك ضرورة أخرى تقتضي «تحليل» هذا التاريخ. فلابدّ لنا من الخوض في تحليل أحداث تاريخ الإسلام، فلا مناص من هذا الأمر ولا نستطيع أن نحصل على تحليل دقيق وصائب للأحداث بكل بساطة. فإننا إن لم نستطع أن نحلّل حدثا تاريخيا ما فذلك يدلّ على أننا لم نفهمه. ومن جانب آخر إذا أعطينا تحليلا خاطئا عن الحدث فيدل على أننا فهمناه بشكل خاطئ.
إن الذي يعطي تحليلا خاطئا وغير صائب للتاريخ الإسلامي كالذي استنبط مفهوما خاطئا من القرآن أو ترجمه وفسره بغير صواب. فكما أن القرآن هو مصدر فهم الدين، كذلك تاريخ الإسلام فهو من مصادر فهم الدين أيضا.
یتبع إن شاء الله...
نحن اليوم بحاجة إلى مرور تاريخ الإسلام أكثر من أي زمان آخر/ لا ينبغي أن نكتفي بمرتكزاتنا المشهورة عن تاريخ الإسلام
لقد أصبحنا في هذا الزمان بحاجة إلى تاريخ الإسلام أكثر من أي زمان آخر. حيث إن الظروف الراهنة التي نعيشها الآن تقتضي إدراكنا العميق للدين أكثر من الأزمنة الماضية. إن الكثير من الاختلافات في الآراء لم تعد ترتبط بأصل الدين وحقّانيته، بل بعض الاستنباطات السطحيّة من الدين هي التي تثير المشاكل.
إن مدى حاجتنا اليوم إلى تاريخ الإسلام أوسع من أن نكتفي ببعض القضايا المشهورة في التاريخ. فهناك الكثير من القضايا والتفاصيل القطعية والثابتة في تاريخ الإسلام ولكنها غير مشهورة وعادة ما لا تؤخذ بعين الاعتبار مع أنها نافعة جدا في رؤيتنا تجاه تاريخ الإسلام.
لابدّ لنا من دراسة تاريخ الإسلام بمزيد من الدقة وذلك من أجل الحصول على معرفة عميقة وصحيحة بأصل الدين. ثم إن المسائل التاريخية التي تمّ تناقلها جيلا بعد جيل واشتهرت على الألسن لم تكن المسائل الرئيسة في التاريخ بالضرورة كما ليس بالضرورة أن تكون هذه المشهورات متناسبة مع ما يقتضيه واقع مجتمعنا اليوم. لقد تطور مجتمعنا كثيرا وهذا ما يفرض علينا أن نراجع الزوايا الخفية في تاريخ الإسلام أكثر من قبل.
إن الاكتفاء بالقضايا التاريخية المشهورة قد يحرفنا عن الصواب في استنتاجنا من التاريخ، ولا شك في أن النتيجة الخاطئة التي نخرج بها من التاريخ قد تؤدي إلى عدم الصواب في فهم الإسلام بشكل عام.
فعلى سبيل المثال كان تحليل الشيخ بهجت(رض) عن قيام الإمام الحسين(ع) قائما على بعض الحقائق غير المشهورة في تاريخ الطفّ. فقد قال سماحته مستندا إلى الوثائق التاريخية: بعدما رأى الإمام الحسين(ع) عدم وجود الناصر، رضي بأن يكفّ عن محاربة يزيد والقيام ضدّ الحكومة كما فعل أخوه الإمام الحسن(ع) مع معاوية. فقد اقترح الإمام الحسين(ع) هذا الأمر على عمر بن سعد حينما التقى به في كربلاء، ولكن أبى ذلك عمر بن سعد حيث كان قد حصر الطرق على أبي عبد الله الحسين(ع) بين القتال أو الاستسلام؛ أي يستسلم له حتى يبعثه مكبلا إلى يزيد ويقرّر هو عند ذلك في أن يقتله أم يطلق سراحه. ولذلك قال الحسين(ع): «ألا! و إنّ الدّعیّ بن الدّعیّ قد رکز بین اثنتین: بین السّلّۀ والذّلّۀ، و هیهات منّا الذّلۀ، یأبی اللهُ لنا ذلک و رسوله والمؤمنون.»[اللهوف/ص97- الاحتجاج/ج2/ص300]
مضافا إلى «الاطلاع» على تاريخ الإسلام نحن بحاجة إلى «تحليله»/ إن لم يكن لدينا تحليل تجاه حدث اجتماعي فهذا يعني أننا لم نفهمه/ إن التاريخ أحد مصادر فهم الإسلام كالقرآن
مضافا إلى ضرورة التعرف على تاريخ الإسلام، هناك ضرورة أخرى تقتضي «تحليل» هذا التاريخ. فلابدّ لنا من الخوض في تحليل أحداث تاريخ الإسلام، فلا مناص من هذا الأمر ولا نستطيع أن نحصل على تحليل دقيق وصائب للأحداث بكل بساطة. فإننا إن لم نستطع أن نحلّل حدثا تاريخيا ما فذلك يدلّ على أننا لم نفهمه. ومن جانب آخر إذا أعطينا تحليلا خاطئا عن الحدث فيدل على أننا فهمناه بشكل خاطئ.
إن الذي يعطي تحليلا خاطئا وغير صائب للتاريخ الإسلامي كالذي استنبط مفهوما خاطئا من القرآن أو ترجمه وفسره بغير صواب. فكما أن القرآن هو مصدر فهم الدين، كذلك تاريخ الإسلام فهو من مصادر فهم الدين أيضا.
یتبع إن شاء الله...
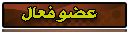


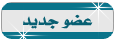
تعليق