موقف الرسول من مستقبل الدعوة
نحاول أن نعالج في هذا المبحث مسألة هامة وحساسة، سبق وأن اختلف المسلمون في فهمها، وأعني بها مسألة خلافة النبي ومستقبل الدعوة الإسلامية وقيادتها من بعده.
وهذا المبحث هو بمثابة مدخل ضروري لفهم الظروف والملابسات الإجتماعية والسياسية التي عاشها علي عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إن الموقف النبوي1 الذي يعالجه هذا البحث بالإمكان استخلاصه والوصول إليه بالإستنتاج المنطقي للدعوة التي كان الرسول الأعظم يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكونها ونوع الظروف التي عاشها.
من المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفاجئه الموت مفاجأة، وكان يدرك منذ فترة قبل وفاته أن أجله قد دنا وقد أعلن عن ذلك بوضوح في حجة الوداع، وهذا يعني أنه كان يملك فرصة كافية للتفكير في مستقبل الإسلام بعده، هذا إذا لم ندخل في الموقف (النصوص التشريعية) أو عامل الإتصال الغيبي والتخطيط الإلهي المباشر للرسالة عن طريق الوحي، هذا التخطيط الذي حدد بوضوح الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي هذا الضوء يمكننا أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمامه ثلاثة طرق بالإمكان انتهاجها تجاه مستقبل الدعوة:
v الطريق الأول:
أن يقف من مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً ويكتفي بممارسة دوره في قيادة الدعوة وتوجيهها فترة حياته ويترك مستقبلها للظروف والصدف.
وهذه السلبية لا يمكن افتراضها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها إنما تنشأ من أحد أمرين كلاهما لا ينطبقان عليه صلى الله عليه وآله وسلم :
الأمر الأول:
الإعتقاد بأن هذه السلبية والإهمال لا تؤثر على مستقبل الدعوة، وأن الأمة التي سوف يخلف الدعوة فيها قادرة على التصرف بالشكل الذي يحمي الدعوة ويضمن عدم الإنحراف.
وهذا الإعتقاد لا مبرر له من الواقع إطلاقاً بل إن طبيعة الأشياء كانت تدل على خلافه لأن الدعوة بحكم كونها عملاً تغييرياً انقلابياً في بدايته، يستهدف بناء أمة واستئصال كل جذور الجاهلية منها تتعرض لأكبر الأخطار إذا خلت الساحة من قائدها وتركها دون أي تخطيط:
أ- فهناك الأخطار التي تنبع عن طبيعة مواجهة الفراغ دون أي تخطيط سابق، مما يدفع الأمة إلى اتخاذ موقف مرتجل في ظل الصدمة العظيمة بفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي لا تملك أي مفهوم مسبق بهذا الصدد.
ب- وهناك الأخطار التي تنجم عن عدم النضج الرسالي بدرجة تضمن للنبي مسبقاً موضوعية التصرف الذي سوف يقع، وانسجامه مع الإطار الرسالي للدعوة وتغلبه على التناقضات الكامنة التي كانت لا تزال تعيش في زوايا من نفوس المسلمين على أساس الإنقسام إلى مهاجرين وأنصار أو قريش وسائر العرب أو مكة والمدينة.
ج- وهناك الأخطار التي تنشأ نتيجة لوجود القطاع المتستر بالإسلام المنافقون والذي كان يكيد للدعوة في حياة النبي باستمرار. وإذا أضفنا إليهم عدداً كبيراً ممن أسلم بعد الفتح استسلاماً للأمر الواقع لا انفتاحاً على الحقيقة،نستطيع أن نقدر الخطر الذي يمكن لهذه العناصر أن تولده وهي تجد فجأة فرصة لنشاط واسع في فراغ كبير مع خلو الساحة من رعاية القائد.
هذا بالإضافة إلى الأخطار الخارجية على الدعوة من القوى والدول القريبة والبعيدة.
فلم تكن إذن خطورة الموقف بعد وفاة النبي شيئاً خافياً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. ولذا رأينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: "ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً".
وإذا كان أبو بكر لم يشأ أن يترك الساحة دون أن يتدخل تدخلاً إيجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة الإحتياط للأمر، وإذا كان الناس قد هرعوا إلى عمر حين ضرب قائلين يا أمير المؤمنين لو عهدت عهداً2 خوفاً من الفراغ الذي سوف يخلفه، بالرغم من التركيز السياسي والإجتماعي الذي كانت الأمة قد بلغته بعد عقد من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان عمر قد أوصى إلى ستة تجاوباً مع شعور الاخرين بالخطر وأبو بكر نفسه يعتذر عن تسرعه إلى قبول الحكم، وعمر يقول عن بيعة أبي بكر "كانت فلتة غير أن الله وقى شرها"3.
إذا كان كل ذلك، فمن البديهي إذن أن يكون رائد الدعوة ونبيها أكثر شعوراً بخطر السلبية وأكبر إدراكاً وأعمق فهماً لطبيعة الموقف ومتطلبات العمل التغييري الذي يمارسه في أمة حديثة عهد بالجاهلية على حد تعبير أبي بكر.
والأمر الثاني:
الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد اتجاه مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته، أنه بالرغم من شعوره بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضد ذلك الخطر لأنه ينظر إلى الدعوة نظرة مصلحية فلا يهمه إلا أن يحافظ عليها ما دام حياً ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبها ولا يعنى بحماية مستقبلها بعد وفاته.
وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا لم نلاحظ بوصفه نبياً ومرتبطاً بالله، وافترضناه قائداً رسالياً كقادة الرسالات الأخرى، تاريخ القادة الرساليين لا يملك نظيراً للقائد الرسول في إخلاصه وتفانيه للدعوة وتضحيته من أجلها إلى اخر
لحظة من حياته وهو على فراش الموت، وهو يحمل همّ معركة كان قد خطط لها وجهز جيش أسامة لخوضها4، فإذا كان اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقضية من قضايا الدعوة العسكرية يبلغ إلى هذه الدرجة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فكيف يمكن أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيش هموم مستقبل الدعوة ولا يخطط لسلامتها بعد وفاته من الأخطار المرتقبة.
فالقائد الأعظم كان أبعد ما يكون عن فرضية الموقف السلبي تجاه مستقبل الدعوة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً"5.
فإن هذه المحاولة من القائد الكريم المتفق على نقلها وصحتها تدل بكل وضوح على أنه كان يفكر في أخطار المستقبل ويدرك بعمق ضرورة التخطيط لتحصين الأمة من الإنحراف وحماية الدعوة من التميع والإنهيار.
v الطريق الثاني:
أن يخطط الرسول القائد لمستقبل الدعوة بعد وفاته ويتخذ موقفاً إيجابياً فيجعل القيمومة على الدعوة وقيادة التجربة للأمة ممثلة على أساس نظام الشورى في جيلها العقائدي الأول والذي سيكون قاعدة للحكم ومحوراً لقيادة الدعوة في خط نموها.
وهذا الافتراض أيضاً مرفوض للأسباب التالية:
1- لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاً إيجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة التي تنبثق عن هذا النظام، لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف أن يقوم الرسول بعملية توعية الأمة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله، وإعطائه طابعاً دينياً مقدساً وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداً فكرياً وروحياً لتقبل هذا النظام، وخصوصاً أن المجتمع انذاك
كان يعيش وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حدّ كبير.
ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله التشريعية، ولو أن هذه العملية كانت قد أنجزت، لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد في أحاديثه المأثورة، وفي ذهنية الأمة أو على أقل تقدير في ذهنية الجيل الطليعي منها بوصفه المكلف بتطبيق نظام الشورى.
ونتأكد من ذلك، موقف لأبي بكر حينما اشتدت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب عندما أمر عثمان أن يكتب عهده وكتب: "أما بعد وفاتي فإني قد استعملت عليكم عمر ابن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا" ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال كيف أصبحت يا خليفة رسول الله، فقال "أصبحت مولياً وقد زدتموني على ما بي إذ رأيتموني استعملت رجلاً منكم فكلكم قد أصبح ورماً أنفه وكل يطلبها لنفسه"6.
وواضح كم هذا الإستخلاف وهذا الاستنكار للمعارضين أن الخليفة لم يكن يفكر بعقلية نظام الشورى وأنه كان يرى من حقه تعيين الخليفة وفرضه على المسلمين، وهكذا كان عمر هو الاخر يرى من حقه فرض الخليفة على المسلمين، دون أن يجعل لسائر المسلمين دور حقيقي في الإنتخاب.
إن الطريقة التي مارسها الخليفة الأول والثاني للإستخلاف وعدم استنكار المسلمين لتلك الطريقة والروح العامة التي سادت على منطق المتنافسين على الخلافة يوم السقيفة، وإعلان أبي بكر الذي فاز بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبي عن صاحب الأمر بعده7، كل ذلك يوضح بدرجة لا تقبل الشك، أن هذا الجيل الطليعي الذي تسلم الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفكر بذهنية الشورى ولم يكن يملك فكرة محددة عن هذا النظام.
2- إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان قد قرر أن يجعل من الجيل الإسلامي الرائد الذي يضم المهاجرين والأنصار من صحابته قيّماً على الدعوة بعده ومسؤولاً عن مواصلة عملية
التغيير فهذا يحتم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبىء هذا الجيل تعبئة رسالية وفكرية واسعة يستطيع أن يمسك بالنظرية بعمق ويمارس التطبيق على ضوئها بوعي ويضع للمشاكل التي تواجهها الدعوة باستمرار حلولها النابعة من الرسالة، خصوصاً إذا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وهو الذي بشّر بسقوط كسرى وقيصر يعلم بأن الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة، وسوف تواجه الأمة الإسلامية مسؤولية توعية تلك الشعوب على الإسلام وتحصين الأمة من أخطار هذا الإنفتاح وتطبيق أحكام الشريعة على الأرض المفتوحة، وأهلها، وبالرغم من أن الجيل الرائد كان أنظف الأجيال التي توارثت الدعوة إلى ذلك الحين، وأكثرها استعداداً للتضحية، لا نجد فيه ملامح ذلك الإعداد الخاص للقيمومة على الدعوة والتثقيف الواسع العميق على مفاهيمها.
ويمكن أن نلاحظ أن مجموع ما نقله الصحابة من نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجال التشريع لا يتجاوز بضع مئات من الأحاديث بينما كان عدد الصحابة يناهز اثني عشر ألفاً على ما أحصته كتب التاريخ، والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون ابتداء النبي بالسؤال حتى أن أحدهم كان ينتظر فرصة مجيء إعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع الجواب، وكانوا يرون أن من الترف الذي يجب الترفع عنه السؤال عن حكم قضايا لم تقع بعد. وعمر بن الخطاب يقول: "لا يحل لأحدٍ أن يسأل عما لم يكن إن الله قد قضى فيما هو كائن"، وابن عمر يجيب أحداً عندما سأله عن شيء، قوله: "لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن"8.
وهكذا نلاحظ اتجاهاً لدى الصحابة إلى العزوف عن السؤال إلا في حدود المشاكل الواقعية المحددة..
وهذا الإتجاه أبعد ما يكون عن عملية الإعداد الرسالي الخاص التي كانت تتطلب تثقيفاً واسعاً لذلك الجيل وتوعية له على حلول الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها عبر قيادته.
وقد أثبتت الأحداث بعد وفاة النبي أن جيل المهاجرين والأنصار لم يكن يملك أي
تعليمات محددة عن كثير من المشاكل الكبيرة التي كان من المفروض أن تواجهها الدعوة بعد النبي، حتى أن المساحة الهائلة من الأرض التي امتد إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي يسنده أي تصور محدد عن حكمها الشرعي وعما إذا كانت تقسم بين المقاتلين أو تجعل وقفاً على المسلمين، كما حدث ذلك لدى فتح العراق.
بل إننا نلاحظ أكثر من ذلك أن الجيل المعاصر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يملك تصورات واضحة حتى في مجال القضايا الدينية، على سبيل المثال، الصلاة على الميت، فإنها عبادة كان النبي قد مارسها مئات المرات وأداها في مشهد عام من المشيعين والمصلين، وبالرغم من ذلك يبدو أن الصحابة كانوا لا يجدون ضرورة لضبط صورة هذه العبادة، ولهذا وقع الإختلاف بينهم في أدائها9.
وهكذا نجد أن الصحابة كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلون غالباً على شخص النبي ولا يشعرون بضرورة الإستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف النبي.
وكل ما تقدم يدل على أن التوعية التي مارسها النبي على المستوى العام للمهاجرين والأنصار لم تجعلهم بالدرجة التي يطلبها إعداد القيادة الواعية الفكرية والسياسية لمستقبل الدعوة وعملية التغيير وإنما كانت توعية بالدرجة التي تبني القاعدة الشعبية الواعية التي تلتف حول قيادة الدعوة في الحاضر والمستقبل.
3- إن الدعوة عملية تغيير ومنهج حياة جديد وهي تستهدف بناء أمة من جديد واقتلاع كل جذور الجاهلية ورواسبها، والأمة الإسلامية ككل لم تكن قد عاشت في ظل عملية التغيير هذه إلا عقداً واحداً من الزمن، وهذا الزمن لا يكفي عادة في منطق الرسالات العقائدية والدعوات التغييرية لارتفاع الجيل إلى درجة من الوعي والموضوعية والتحرر من رواسب الماضي والاستيعاب لمعطيات الأطروحة الجديدة تؤهله للقيمومة على الرسالة وتحمل مسؤوليات الدعوة وعملية التغيير بدون قائد، بل إن منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تمر الأمة بوصاية عقائدية فترة أطول من الزمن حتى تتهيأ للإرتفاع إلى مستوى تلك القيمومة.
وفعلاً نلاحظ عبر نصف قرن أو أقل من خلال ممارسة جيل المهاجرين والأنصار لإمامة الدعوة والقيمومة عليها، أنه لم يمض على هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة والتجربة الإسلامية تنهار تحت وقع ضربات أعداء الإسلام القدامى، إذ استطاعوا أن يتسللوا إلى مراكز النفوذ في التجربة بالتدريج ويستغفلوا القيادة غير الواعية ثم صادروا بكل تجرؤ وعنف تلك القيادة وأجبروا الأمة على الخضوع لقيادتهم فتحولت الزعامة إلى ملك موروث يستهتر بالكرامات ويقتل الأبرياء ويعطل الحدود، وأصبح الفيء والسواد بستاناً لقريش والخلافة كرة يتلاعب بها صبيان بني أميّة.
v الطريق الثالث:
وهو الطريق الوحيد الذي بقي منسجماً مع طبيعة الأشياء ومعقولاً على ضوء ظروف الدعوة وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفاً إيجابياً، فيختار بأمر من الله سبحانه شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة فيعده إعداداً رسالياً وقيادياً خاصاً تتمثل فيه القيادة الفكرية السياسية للتجربة وليواصل بعده بمساندة القاعدة الشعبية الواعية قيادة الأمة وبناءها العقائدي.
وهكذا نجد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل الدعوة وصيانة التجربة من الإنحراف في خط نموها وهكذا كان.
وليس ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصوص التي تدل على أنه كان يمارس إعداداً رسالياً وتثقيفاً عقائدياً خاصاً لبعض الأشخاص على مستوى يهيئه للمرجعية الفكرية والزعامة السياسية وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إليه بمستقبل الدعوة وزعامة الأمة من بعده فكرياً وسياسياً، ليس هذا إلا تعبيراً عن سلوك القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للطريق الثالث الذي كانت تفرضه وتدل عليه قبل ذلك طبيعة الأشياء، كما عرفنا.
ولم يكن هذا الشخص الداعية المرشح للإعداد الرسالي القيادي وتزعمها فكرياً وسياسياً سوى علي بن أبي طالب الذي رشحه لذلك عمق وجوده في كيان الدعوة وأنه المجاهد الأول في سبيلها عبر كفاحها المرير ضد كل أعدائها، وأنه ربيب الرسول الذي
فتح عينيه في حجره، ونشأ في كنفه وتهيأت له فرص التفاعل معه والإندماج بخطه ما لم يتوفر لأي إنسان اخر.
والشواهد من حياة النبي والإمام علي على أن النبي كان يعد الإمام إعداداً رسالياً خاصاً كثيرة جداً، فقد كان الرسول يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها ويبدأه بالعطاء الفكري إذا استنفذ الإمام أسئلته ويختلي به الساعات الطوال يفتح عينيه على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل إلى اخر يوم من حياته الشريفة.
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت قثم بن العباس، كيف ورث علي رسول الله؟ قال: "لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً".
وروى النسائي عن الإمام عليه السلام أنه كان يقول: "كنت إذا سألت رسول الله أعطيت وإذا سكت ابتدأني"، ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته وهو يصف ارتباطه الفريد بالرسول وعناية النبي بإعداده وتربيته (وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة...ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالإقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة).
كما أن في حياة الإمام علي عليه السلام بعد وفاة القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرقاماً كثيرة جداً تكشف عن ذلك الإعداد العقائدي الخاص للإمام علي عليه السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تعكسه من اثار ذلك الإعداد الخاص ونتائجه، فقد كان الإمام هو المفزع والمرجع لحل أي مشكلة يستعصي حلها على القيادة الحاكمة وقتئذٍ ولا نعرف في تاريخ التجربة الإسلامية على عهد الخلفاء الأربعة واقعة واحدة رجع فيها الإمام إلى غيره لكي يتعرف رأي الإسلام وطريقة علاجه للموقف بينما نعرف في التاريخ عشرات الوقائع التي أحست القيادة الإسلامية الحاكمة فيها بضرورة الرجوع إلى الإمام بالرغم من تحفظاتها في هذا الموضوع.
وإذا كانت الشواهد كثيرة على أن النبي كان يعد الإمام إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة
الدعوة من بعده فالشواهد على إعلان الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم عن تخطيطه هذا وإسناده زعامة الدعوة الفكرية والسياسية رسمياً إلى الإمام علي عليه السلام لا تقل عنها كثرة كما نلاحظ ذلك في حديث الدار، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث الغدير وعشرات من النصوص النبوية الأخرى10.
هوامش
1- اعتمدنا في هذا المبحث ( موقف الرسول من مستقبل الدعوة) بتصرف ما جاء في كتاب بحث في الولاية لسماحة السيد محمد باقر الصدر مع اختصار وإغفال لبعض الشواهد التاريخية، لضيق المجال فنحيل القارئ إليها.
2- تاريخ الطبري ج5، ص34.
3- تاريخ الطبري ج3، ص200 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج6، ص42.
4- راجع الكامل لابن الأثير وغيره.
5- وهو حديث أجمعت السنة والشيعة على نقله، راجع مسند أحمد ج 1، ص355 وصحيح مسلم ج2 وصحيح البخاري، ج 1.
6- تاريخ اليعقوبي ج2، ص127 126.
7- راجع في نصوص يوم السقيفة شرح نهج البلاغة، ج6، ص9 6.
8- سنن الدارمي ج1، ص56.
9- راجع عمدة القارئ، ج4، ص129، للوقوف على تفاصيل الإختلاف.
10- راجع النصوص وزيادة المعلومات المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين.
نحاول أن نعالج في هذا المبحث مسألة هامة وحساسة، سبق وأن اختلف المسلمون في فهمها، وأعني بها مسألة خلافة النبي ومستقبل الدعوة الإسلامية وقيادتها من بعده.
وهذا المبحث هو بمثابة مدخل ضروري لفهم الظروف والملابسات الإجتماعية والسياسية التي عاشها علي عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إن الموقف النبوي1 الذي يعالجه هذا البحث بالإمكان استخلاصه والوصول إليه بالإستنتاج المنطقي للدعوة التي كان الرسول الأعظم يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكونها ونوع الظروف التي عاشها.
من المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفاجئه الموت مفاجأة، وكان يدرك منذ فترة قبل وفاته أن أجله قد دنا وقد أعلن عن ذلك بوضوح في حجة الوداع، وهذا يعني أنه كان يملك فرصة كافية للتفكير في مستقبل الإسلام بعده، هذا إذا لم ندخل في الموقف (النصوص التشريعية) أو عامل الإتصال الغيبي والتخطيط الإلهي المباشر للرسالة عن طريق الوحي، هذا التخطيط الذي حدد بوضوح الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي هذا الضوء يمكننا أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمامه ثلاثة طرق بالإمكان انتهاجها تجاه مستقبل الدعوة:
v الطريق الأول:
أن يقف من مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً ويكتفي بممارسة دوره في قيادة الدعوة وتوجيهها فترة حياته ويترك مستقبلها للظروف والصدف.
وهذه السلبية لا يمكن افتراضها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها إنما تنشأ من أحد أمرين كلاهما لا ينطبقان عليه صلى الله عليه وآله وسلم :
الأمر الأول:
الإعتقاد بأن هذه السلبية والإهمال لا تؤثر على مستقبل الدعوة، وأن الأمة التي سوف يخلف الدعوة فيها قادرة على التصرف بالشكل الذي يحمي الدعوة ويضمن عدم الإنحراف.
وهذا الإعتقاد لا مبرر له من الواقع إطلاقاً بل إن طبيعة الأشياء كانت تدل على خلافه لأن الدعوة بحكم كونها عملاً تغييرياً انقلابياً في بدايته، يستهدف بناء أمة واستئصال كل جذور الجاهلية منها تتعرض لأكبر الأخطار إذا خلت الساحة من قائدها وتركها دون أي تخطيط:
أ- فهناك الأخطار التي تنبع عن طبيعة مواجهة الفراغ دون أي تخطيط سابق، مما يدفع الأمة إلى اتخاذ موقف مرتجل في ظل الصدمة العظيمة بفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي لا تملك أي مفهوم مسبق بهذا الصدد.
ب- وهناك الأخطار التي تنجم عن عدم النضج الرسالي بدرجة تضمن للنبي مسبقاً موضوعية التصرف الذي سوف يقع، وانسجامه مع الإطار الرسالي للدعوة وتغلبه على التناقضات الكامنة التي كانت لا تزال تعيش في زوايا من نفوس المسلمين على أساس الإنقسام إلى مهاجرين وأنصار أو قريش وسائر العرب أو مكة والمدينة.
ج- وهناك الأخطار التي تنشأ نتيجة لوجود القطاع المتستر بالإسلام المنافقون والذي كان يكيد للدعوة في حياة النبي باستمرار. وإذا أضفنا إليهم عدداً كبيراً ممن أسلم بعد الفتح استسلاماً للأمر الواقع لا انفتاحاً على الحقيقة،نستطيع أن نقدر الخطر الذي يمكن لهذه العناصر أن تولده وهي تجد فجأة فرصة لنشاط واسع في فراغ كبير مع خلو الساحة من رعاية القائد.
هذا بالإضافة إلى الأخطار الخارجية على الدعوة من القوى والدول القريبة والبعيدة.
فلم تكن إذن خطورة الموقف بعد وفاة النبي شيئاً خافياً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. ولذا رأينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: "ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً".
وإذا كان أبو بكر لم يشأ أن يترك الساحة دون أن يتدخل تدخلاً إيجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة الإحتياط للأمر، وإذا كان الناس قد هرعوا إلى عمر حين ضرب قائلين يا أمير المؤمنين لو عهدت عهداً2 خوفاً من الفراغ الذي سوف يخلفه، بالرغم من التركيز السياسي والإجتماعي الذي كانت الأمة قد بلغته بعد عقد من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان عمر قد أوصى إلى ستة تجاوباً مع شعور الاخرين بالخطر وأبو بكر نفسه يعتذر عن تسرعه إلى قبول الحكم، وعمر يقول عن بيعة أبي بكر "كانت فلتة غير أن الله وقى شرها"3.
إذا كان كل ذلك، فمن البديهي إذن أن يكون رائد الدعوة ونبيها أكثر شعوراً بخطر السلبية وأكبر إدراكاً وأعمق فهماً لطبيعة الموقف ومتطلبات العمل التغييري الذي يمارسه في أمة حديثة عهد بالجاهلية على حد تعبير أبي بكر.
والأمر الثاني:
الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد اتجاه مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته، أنه بالرغم من شعوره بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضد ذلك الخطر لأنه ينظر إلى الدعوة نظرة مصلحية فلا يهمه إلا أن يحافظ عليها ما دام حياً ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبها ولا يعنى بحماية مستقبلها بعد وفاته.
وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا لم نلاحظ بوصفه نبياً ومرتبطاً بالله، وافترضناه قائداً رسالياً كقادة الرسالات الأخرى، تاريخ القادة الرساليين لا يملك نظيراً للقائد الرسول في إخلاصه وتفانيه للدعوة وتضحيته من أجلها إلى اخر
لحظة من حياته وهو على فراش الموت، وهو يحمل همّ معركة كان قد خطط لها وجهز جيش أسامة لخوضها4، فإذا كان اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقضية من قضايا الدعوة العسكرية يبلغ إلى هذه الدرجة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فكيف يمكن أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيش هموم مستقبل الدعوة ولا يخطط لسلامتها بعد وفاته من الأخطار المرتقبة.
فالقائد الأعظم كان أبعد ما يكون عن فرضية الموقف السلبي تجاه مستقبل الدعوة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً"5.
فإن هذه المحاولة من القائد الكريم المتفق على نقلها وصحتها تدل بكل وضوح على أنه كان يفكر في أخطار المستقبل ويدرك بعمق ضرورة التخطيط لتحصين الأمة من الإنحراف وحماية الدعوة من التميع والإنهيار.
v الطريق الثاني:
أن يخطط الرسول القائد لمستقبل الدعوة بعد وفاته ويتخذ موقفاً إيجابياً فيجعل القيمومة على الدعوة وقيادة التجربة للأمة ممثلة على أساس نظام الشورى في جيلها العقائدي الأول والذي سيكون قاعدة للحكم ومحوراً لقيادة الدعوة في خط نموها.
وهذا الافتراض أيضاً مرفوض للأسباب التالية:
1- لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاً إيجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة التي تنبثق عن هذا النظام، لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف أن يقوم الرسول بعملية توعية الأمة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله، وإعطائه طابعاً دينياً مقدساً وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداً فكرياً وروحياً لتقبل هذا النظام، وخصوصاً أن المجتمع انذاك
كان يعيش وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حدّ كبير.
ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله التشريعية، ولو أن هذه العملية كانت قد أنجزت، لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد في أحاديثه المأثورة، وفي ذهنية الأمة أو على أقل تقدير في ذهنية الجيل الطليعي منها بوصفه المكلف بتطبيق نظام الشورى.
ونتأكد من ذلك، موقف لأبي بكر حينما اشتدت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب عندما أمر عثمان أن يكتب عهده وكتب: "أما بعد وفاتي فإني قد استعملت عليكم عمر ابن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا" ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال كيف أصبحت يا خليفة رسول الله، فقال "أصبحت مولياً وقد زدتموني على ما بي إذ رأيتموني استعملت رجلاً منكم فكلكم قد أصبح ورماً أنفه وكل يطلبها لنفسه"6.
وواضح كم هذا الإستخلاف وهذا الاستنكار للمعارضين أن الخليفة لم يكن يفكر بعقلية نظام الشورى وأنه كان يرى من حقه تعيين الخليفة وفرضه على المسلمين، وهكذا كان عمر هو الاخر يرى من حقه فرض الخليفة على المسلمين، دون أن يجعل لسائر المسلمين دور حقيقي في الإنتخاب.
إن الطريقة التي مارسها الخليفة الأول والثاني للإستخلاف وعدم استنكار المسلمين لتلك الطريقة والروح العامة التي سادت على منطق المتنافسين على الخلافة يوم السقيفة، وإعلان أبي بكر الذي فاز بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبي عن صاحب الأمر بعده7، كل ذلك يوضح بدرجة لا تقبل الشك، أن هذا الجيل الطليعي الذي تسلم الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفكر بذهنية الشورى ولم يكن يملك فكرة محددة عن هذا النظام.
2- إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان قد قرر أن يجعل من الجيل الإسلامي الرائد الذي يضم المهاجرين والأنصار من صحابته قيّماً على الدعوة بعده ومسؤولاً عن مواصلة عملية
التغيير فهذا يحتم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبىء هذا الجيل تعبئة رسالية وفكرية واسعة يستطيع أن يمسك بالنظرية بعمق ويمارس التطبيق على ضوئها بوعي ويضع للمشاكل التي تواجهها الدعوة باستمرار حلولها النابعة من الرسالة، خصوصاً إذا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وهو الذي بشّر بسقوط كسرى وقيصر يعلم بأن الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة، وسوف تواجه الأمة الإسلامية مسؤولية توعية تلك الشعوب على الإسلام وتحصين الأمة من أخطار هذا الإنفتاح وتطبيق أحكام الشريعة على الأرض المفتوحة، وأهلها، وبالرغم من أن الجيل الرائد كان أنظف الأجيال التي توارثت الدعوة إلى ذلك الحين، وأكثرها استعداداً للتضحية، لا نجد فيه ملامح ذلك الإعداد الخاص للقيمومة على الدعوة والتثقيف الواسع العميق على مفاهيمها.
ويمكن أن نلاحظ أن مجموع ما نقله الصحابة من نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجال التشريع لا يتجاوز بضع مئات من الأحاديث بينما كان عدد الصحابة يناهز اثني عشر ألفاً على ما أحصته كتب التاريخ، والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون ابتداء النبي بالسؤال حتى أن أحدهم كان ينتظر فرصة مجيء إعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع الجواب، وكانوا يرون أن من الترف الذي يجب الترفع عنه السؤال عن حكم قضايا لم تقع بعد. وعمر بن الخطاب يقول: "لا يحل لأحدٍ أن يسأل عما لم يكن إن الله قد قضى فيما هو كائن"، وابن عمر يجيب أحداً عندما سأله عن شيء، قوله: "لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن"8.
وهكذا نلاحظ اتجاهاً لدى الصحابة إلى العزوف عن السؤال إلا في حدود المشاكل الواقعية المحددة..
وهذا الإتجاه أبعد ما يكون عن عملية الإعداد الرسالي الخاص التي كانت تتطلب تثقيفاً واسعاً لذلك الجيل وتوعية له على حلول الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها عبر قيادته.
وقد أثبتت الأحداث بعد وفاة النبي أن جيل المهاجرين والأنصار لم يكن يملك أي
تعليمات محددة عن كثير من المشاكل الكبيرة التي كان من المفروض أن تواجهها الدعوة بعد النبي، حتى أن المساحة الهائلة من الأرض التي امتد إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي يسنده أي تصور محدد عن حكمها الشرعي وعما إذا كانت تقسم بين المقاتلين أو تجعل وقفاً على المسلمين، كما حدث ذلك لدى فتح العراق.
بل إننا نلاحظ أكثر من ذلك أن الجيل المعاصر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يملك تصورات واضحة حتى في مجال القضايا الدينية، على سبيل المثال، الصلاة على الميت، فإنها عبادة كان النبي قد مارسها مئات المرات وأداها في مشهد عام من المشيعين والمصلين، وبالرغم من ذلك يبدو أن الصحابة كانوا لا يجدون ضرورة لضبط صورة هذه العبادة، ولهذا وقع الإختلاف بينهم في أدائها9.
وهكذا نجد أن الصحابة كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلون غالباً على شخص النبي ولا يشعرون بضرورة الإستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف النبي.
وكل ما تقدم يدل على أن التوعية التي مارسها النبي على المستوى العام للمهاجرين والأنصار لم تجعلهم بالدرجة التي يطلبها إعداد القيادة الواعية الفكرية والسياسية لمستقبل الدعوة وعملية التغيير وإنما كانت توعية بالدرجة التي تبني القاعدة الشعبية الواعية التي تلتف حول قيادة الدعوة في الحاضر والمستقبل.
3- إن الدعوة عملية تغيير ومنهج حياة جديد وهي تستهدف بناء أمة من جديد واقتلاع كل جذور الجاهلية ورواسبها، والأمة الإسلامية ككل لم تكن قد عاشت في ظل عملية التغيير هذه إلا عقداً واحداً من الزمن، وهذا الزمن لا يكفي عادة في منطق الرسالات العقائدية والدعوات التغييرية لارتفاع الجيل إلى درجة من الوعي والموضوعية والتحرر من رواسب الماضي والاستيعاب لمعطيات الأطروحة الجديدة تؤهله للقيمومة على الرسالة وتحمل مسؤوليات الدعوة وعملية التغيير بدون قائد، بل إن منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تمر الأمة بوصاية عقائدية فترة أطول من الزمن حتى تتهيأ للإرتفاع إلى مستوى تلك القيمومة.
وفعلاً نلاحظ عبر نصف قرن أو أقل من خلال ممارسة جيل المهاجرين والأنصار لإمامة الدعوة والقيمومة عليها، أنه لم يمض على هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة والتجربة الإسلامية تنهار تحت وقع ضربات أعداء الإسلام القدامى، إذ استطاعوا أن يتسللوا إلى مراكز النفوذ في التجربة بالتدريج ويستغفلوا القيادة غير الواعية ثم صادروا بكل تجرؤ وعنف تلك القيادة وأجبروا الأمة على الخضوع لقيادتهم فتحولت الزعامة إلى ملك موروث يستهتر بالكرامات ويقتل الأبرياء ويعطل الحدود، وأصبح الفيء والسواد بستاناً لقريش والخلافة كرة يتلاعب بها صبيان بني أميّة.
v الطريق الثالث:
وهو الطريق الوحيد الذي بقي منسجماً مع طبيعة الأشياء ومعقولاً على ضوء ظروف الدعوة وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفاً إيجابياً، فيختار بأمر من الله سبحانه شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة فيعده إعداداً رسالياً وقيادياً خاصاً تتمثل فيه القيادة الفكرية السياسية للتجربة وليواصل بعده بمساندة القاعدة الشعبية الواعية قيادة الأمة وبناءها العقائدي.
وهكذا نجد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل الدعوة وصيانة التجربة من الإنحراف في خط نموها وهكذا كان.
وليس ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصوص التي تدل على أنه كان يمارس إعداداً رسالياً وتثقيفاً عقائدياً خاصاً لبعض الأشخاص على مستوى يهيئه للمرجعية الفكرية والزعامة السياسية وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إليه بمستقبل الدعوة وزعامة الأمة من بعده فكرياً وسياسياً، ليس هذا إلا تعبيراً عن سلوك القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للطريق الثالث الذي كانت تفرضه وتدل عليه قبل ذلك طبيعة الأشياء، كما عرفنا.
ولم يكن هذا الشخص الداعية المرشح للإعداد الرسالي القيادي وتزعمها فكرياً وسياسياً سوى علي بن أبي طالب الذي رشحه لذلك عمق وجوده في كيان الدعوة وأنه المجاهد الأول في سبيلها عبر كفاحها المرير ضد كل أعدائها، وأنه ربيب الرسول الذي
فتح عينيه في حجره، ونشأ في كنفه وتهيأت له فرص التفاعل معه والإندماج بخطه ما لم يتوفر لأي إنسان اخر.
والشواهد من حياة النبي والإمام علي على أن النبي كان يعد الإمام إعداداً رسالياً خاصاً كثيرة جداً، فقد كان الرسول يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها ويبدأه بالعطاء الفكري إذا استنفذ الإمام أسئلته ويختلي به الساعات الطوال يفتح عينيه على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل إلى اخر يوم من حياته الشريفة.
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت قثم بن العباس، كيف ورث علي رسول الله؟ قال: "لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً".
وروى النسائي عن الإمام عليه السلام أنه كان يقول: "كنت إذا سألت رسول الله أعطيت وإذا سكت ابتدأني"، ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته وهو يصف ارتباطه الفريد بالرسول وعناية النبي بإعداده وتربيته (وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة...ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالإقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة).
كما أن في حياة الإمام علي عليه السلام بعد وفاة القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرقاماً كثيرة جداً تكشف عن ذلك الإعداد العقائدي الخاص للإمام علي عليه السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تعكسه من اثار ذلك الإعداد الخاص ونتائجه، فقد كان الإمام هو المفزع والمرجع لحل أي مشكلة يستعصي حلها على القيادة الحاكمة وقتئذٍ ولا نعرف في تاريخ التجربة الإسلامية على عهد الخلفاء الأربعة واقعة واحدة رجع فيها الإمام إلى غيره لكي يتعرف رأي الإسلام وطريقة علاجه للموقف بينما نعرف في التاريخ عشرات الوقائع التي أحست القيادة الإسلامية الحاكمة فيها بضرورة الرجوع إلى الإمام بالرغم من تحفظاتها في هذا الموضوع.
وإذا كانت الشواهد كثيرة على أن النبي كان يعد الإمام إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة
الدعوة من بعده فالشواهد على إعلان الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم عن تخطيطه هذا وإسناده زعامة الدعوة الفكرية والسياسية رسمياً إلى الإمام علي عليه السلام لا تقل عنها كثرة كما نلاحظ ذلك في حديث الدار، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث الغدير وعشرات من النصوص النبوية الأخرى10.
هوامش
1- اعتمدنا في هذا المبحث ( موقف الرسول من مستقبل الدعوة) بتصرف ما جاء في كتاب بحث في الولاية لسماحة السيد محمد باقر الصدر مع اختصار وإغفال لبعض الشواهد التاريخية، لضيق المجال فنحيل القارئ إليها.
2- تاريخ الطبري ج5، ص34.
3- تاريخ الطبري ج3، ص200 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج6، ص42.
4- راجع الكامل لابن الأثير وغيره.
5- وهو حديث أجمعت السنة والشيعة على نقله، راجع مسند أحمد ج 1، ص355 وصحيح مسلم ج2 وصحيح البخاري، ج 1.
6- تاريخ اليعقوبي ج2، ص127 126.
7- راجع في نصوص يوم السقيفة شرح نهج البلاغة، ج6، ص9 6.
8- سنن الدارمي ج1، ص56.
9- راجع عمدة القارئ، ج4، ص129، للوقوف على تفاصيل الإختلاف.
10- راجع النصوص وزيادة المعلومات المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين.
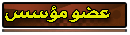



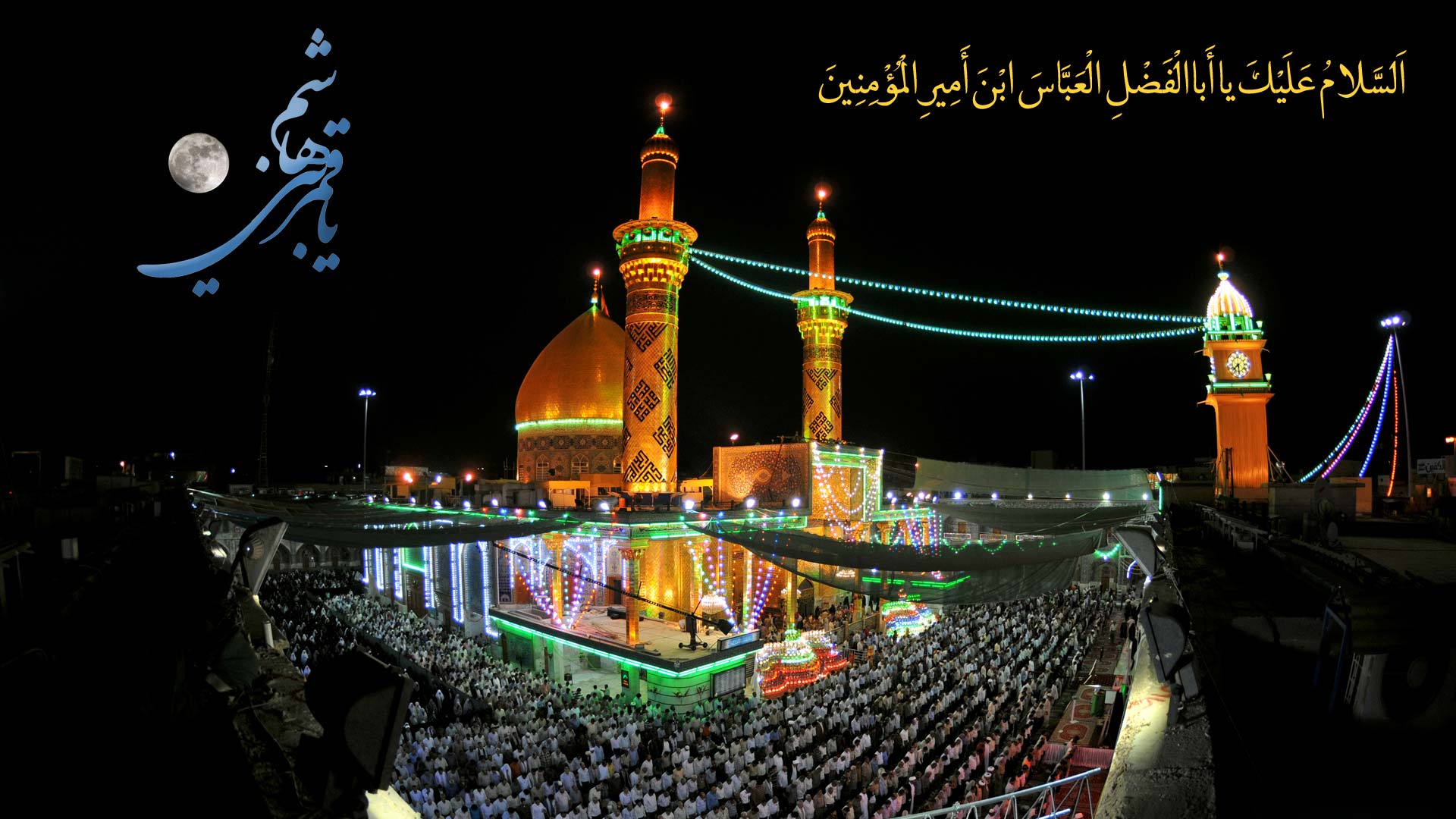



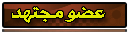
تعليق