بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف نطرح في هذا الموضوع المبارك
اسلوب من اساليب الخطاب في القرأن الكريم
وهو ان يكون مضمون الخطاب في الظاهر يختلف جزئياً او كلياً عن الباطن
تتضح الإجابة عن هذا السؤال في ضوء المقدّمات الثلاث التالية:
المقدّمة الأولى: إن الإنسان في حياته البدائية كان يغرس جميع مزايا وجوده في أرض المادّية، حيث تشتغل حواسّه الظاهرية والباطنية بالمادّة، ومن المعلوم أن أفكاره حينئذ تتبع معلوماته الحسّية، فإن الأكل والشرب والجلوس والقيام والتكلم والاستماع والذهاب والإياب والحركة والسكون وكلّ ما يقوم به الإنسان من الأعمال وضعت أساسها على المادّة وخواصها. وأما ما نراه منه في بعض الأحيان من الآثار المعنوية ـ كالحب والعداء وعلوّ الهمّة ورفعة المقام وأمثالها ـ إنما تدركها بعض الأفهام لأنها تجسّم مصاديق مادّية، فإن الإنسان يقيس حلاوة القلب بحلاوة شيء مادّي حلو كالسكر، وجاذبية الصداقة بجاذبية المغناطيس، وعظم المقام ورفعته بعظم الجبل وما أشبه هذه الأشياء. ومع ذلك تختلف الأفهام في إدراك المعنويات التي هي أوسع نطاقاً من الماديات، فإن بعض الأفهام في غاية الانحطاط في درك الأمور المعنوية، وبعضها تدرك إدراكاً قليلاً وهكذا تتدرج إلى أن تصل بعض الإفهام بسهولة إلى درك أوسع المعنويات وأشرفها.
في ضوء ذلك فإن الأفهام كلّما تقدّمت في درك المعنويات ابتعدت عن المادّة وضعف تعلّقها بالأمور المادّية، وهذا يعني أن الإنسان بطبيعته الإنسانية فيه الاستعداد الذاتي لهذا الإدراك، وبذلك يمكن تربيته وإخراج هذا النوع من الإدراك إلى الفعلية والتحقق.
المقدّمة الثانية: بناءً على ما تمّ في المقدّمة الأولى فإنه لا يمكن حمل ما يدركه الإنسان الذي نال المرتبة العليا من الإدراك والتعقّل، على الذي هو متردّد في المرتبة السفلى من الإدراك، ولو فرض وقوع هذا الحمل لأنتج عكس المطلوب؛ خصوصاً في المعنويات التي هي أشرف وأهمّ من الإدراكات الحسّية المادّية. فلو ألقيت المعارف المعنوية على من لم يرتق لنيل فهمها وإدراكها لكانت سبباً في ضلاله وجهله بدلاً من تكامله وتعقّله، وتكون من قبيل «كسرته وعليك جبره»!
ولعل المثال الأبرز على هذه الحالة أن قسم «أوبانيشاد» من كتاب «ويدا» الذي هو الكتاب البوذي المقدس، ومن خلال المقارنة بين أقواله كان يهدف إلى التوحيد الخالص، إلا أنه استعرض حقائق التوحيد العليا ومسائله العظمى بلا ستار، ونشرها على مستوى أفكار العامّة، وكانت النتيجة لهذا التحميل الخاطئ للمعارف أن يتّجه ضعفاء العقول من الهنود إلى الوثنية وعبادة أوثان شتّى.
المقدّمة الثالثة: إن الدين الإسلامي لم يغلق باب المعرفة في وجه أحد رام طلبها، وهذا بخلافه في الأديان التي حرمت العامّة من كثير من المعارف والمزايا الدينية، كحرمان المرأة في البرهمية واليهودية والمسيحية، وحرمان غير رجال الدين من ثقافة الكتاب المقدس في الوثنية والمسيحية، وأما في الدين الإسلامي فإن المزايا فيه مبسوطة للجميع وليست حكراً على فئة خاصّة، فلا فرق بين العامّة والخاصّة والرجل والمرأة والأبيض والأسود، كلّهم متساوون من الناحية الفكرية في نظر الإسلام، ولهم الحق في تحصيل المزايا الدينية من غير تمييز أحد على آخر؛ قال تعالى: )أنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ((240).
استناداً إلى معطيات هذه المقدّمات الثلاث نرى أن القرآن الكريم ينظر في تعاليمه القيّمة، إلى الإنسانية بما هي إنسانية، أي أنه يوسّع تعاليمه على الإنسان باعتباره قابلاً للتربية والسير في مدارج الكمال.
وحيث إن الإفهام والعقول ذات مستويات متفاوتة في إدراك المعنويات ولا يؤمَن الخطر عند إلقاء المعارف العالية كما تقدّم، نرى القرآن يستعرض تعاليمه بأبسط المستويات التي تناسب العامّة، ويتكلّم في حدود فهمهم وداخل دائرة مداركهم الساذجة.
وهذه الطريقة الحكيمة سوف تنتج بثّ المعارف العالية من خلال اللغة التي يفهمها عامّة الناس، وتقوم ظواهر الألفاظ من خلال هذه الطريقة بعملية الإلقاء بشكل محسوس أو ما يقرب منه، وتبقى الحقائق المعنوية خلف ستار الظواهر وتتجلى حسب الأفهام، وينهل منها كلّ شخص بما له من قوة العقل والإدراك؛ يقول تعالى: )إنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٭ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ((241). ويقول ممثّلاً للحق والباطل ومقدار الأفهام: )أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها((242). ويقول النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله: «إنّا معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم»(243).
بل يمكن القول إن ثمّة نتيجة أخرى لهذه الطريقة في إلقاء المعارف والعلوم وهي كون ظواهر الآيات أمثالاً بالنسبة إلى بواطنها، أي المعارف الإلهية التي هي أعلى مستوى من أفهام العامّة، فتكون تلك الظواهر أمثالاً تقرّب المعارف المستورة إلى الإفهام؛ قال تعالى: )وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأبى أكْثَرُ النَّاسِ إلاَّ كُفُوراً((244). وقال أيضاً: )وَتِلْكَ الأمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إلاَّ الْعالِمُونَ((245).
وفي القرآن الكريم كثير من الأمثال، إلاّ أن الآيات المذكورة وما في معناها مطلقة لا تختصّ بأمثال قرآنية خاصّة، وعليه لابدّ من القول بأن الآيات كلّها أمثال بالنسبة إلى المعارف العالية التي هي المقصد الأسمى للقرآن.(246)
وبذلك يكون القرآن خارجاً عن قدرة البشر تكويناً، وأنّى للإنسان القاصر والمحدود بقواه المتغيّرة والمتبدّلة أن يأتي بكتاب يدوّن فيه مراتب الواقع العيني على ما هي عليه من النظام البديع والنظم التكويني الرائع؟! فتبارك الله أحسن الخالقين.
)بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ٭ فِي لَوْح مَحْفُوظٍ((247)
مصادر البحث
(240) آل عمران: 195.
(241) الزخرف: 3 ـ 4.
(242) الرعد: 17.
(243) راجع بحار الأنوار: ج1 ص37.
(244) الإسراء: 89.
(245) العنكبوت: 43.
(246) راجع:القرآن في الإسلام، السيد محمدحسين الطباطبائي، ترجمةالسيد أحمدالحسيني ص41 نشر مركز إعلام الذكرى الخامسة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران 1404هـ.
(247) البروج: 21 - 22 .
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف نطرح في هذا الموضوع المبارك
اسلوب من اساليب الخطاب في القرأن الكريم
وهو ان يكون مضمون الخطاب في الظاهر يختلف جزئياً او كلياً عن الباطن
تتضح الإجابة عن هذا السؤال في ضوء المقدّمات الثلاث التالية:
المقدّمة الأولى: إن الإنسان في حياته البدائية كان يغرس جميع مزايا وجوده في أرض المادّية، حيث تشتغل حواسّه الظاهرية والباطنية بالمادّة، ومن المعلوم أن أفكاره حينئذ تتبع معلوماته الحسّية، فإن الأكل والشرب والجلوس والقيام والتكلم والاستماع والذهاب والإياب والحركة والسكون وكلّ ما يقوم به الإنسان من الأعمال وضعت أساسها على المادّة وخواصها. وأما ما نراه منه في بعض الأحيان من الآثار المعنوية ـ كالحب والعداء وعلوّ الهمّة ورفعة المقام وأمثالها ـ إنما تدركها بعض الأفهام لأنها تجسّم مصاديق مادّية، فإن الإنسان يقيس حلاوة القلب بحلاوة شيء مادّي حلو كالسكر، وجاذبية الصداقة بجاذبية المغناطيس، وعظم المقام ورفعته بعظم الجبل وما أشبه هذه الأشياء. ومع ذلك تختلف الأفهام في إدراك المعنويات التي هي أوسع نطاقاً من الماديات، فإن بعض الأفهام في غاية الانحطاط في درك الأمور المعنوية، وبعضها تدرك إدراكاً قليلاً وهكذا تتدرج إلى أن تصل بعض الإفهام بسهولة إلى درك أوسع المعنويات وأشرفها.
في ضوء ذلك فإن الأفهام كلّما تقدّمت في درك المعنويات ابتعدت عن المادّة وضعف تعلّقها بالأمور المادّية، وهذا يعني أن الإنسان بطبيعته الإنسانية فيه الاستعداد الذاتي لهذا الإدراك، وبذلك يمكن تربيته وإخراج هذا النوع من الإدراك إلى الفعلية والتحقق.
المقدّمة الثانية: بناءً على ما تمّ في المقدّمة الأولى فإنه لا يمكن حمل ما يدركه الإنسان الذي نال المرتبة العليا من الإدراك والتعقّل، على الذي هو متردّد في المرتبة السفلى من الإدراك، ولو فرض وقوع هذا الحمل لأنتج عكس المطلوب؛ خصوصاً في المعنويات التي هي أشرف وأهمّ من الإدراكات الحسّية المادّية. فلو ألقيت المعارف المعنوية على من لم يرتق لنيل فهمها وإدراكها لكانت سبباً في ضلاله وجهله بدلاً من تكامله وتعقّله، وتكون من قبيل «كسرته وعليك جبره»!
ولعل المثال الأبرز على هذه الحالة أن قسم «أوبانيشاد» من كتاب «ويدا» الذي هو الكتاب البوذي المقدس، ومن خلال المقارنة بين أقواله كان يهدف إلى التوحيد الخالص، إلا أنه استعرض حقائق التوحيد العليا ومسائله العظمى بلا ستار، ونشرها على مستوى أفكار العامّة، وكانت النتيجة لهذا التحميل الخاطئ للمعارف أن يتّجه ضعفاء العقول من الهنود إلى الوثنية وعبادة أوثان شتّى.
المقدّمة الثالثة: إن الدين الإسلامي لم يغلق باب المعرفة في وجه أحد رام طلبها، وهذا بخلافه في الأديان التي حرمت العامّة من كثير من المعارف والمزايا الدينية، كحرمان المرأة في البرهمية واليهودية والمسيحية، وحرمان غير رجال الدين من ثقافة الكتاب المقدس في الوثنية والمسيحية، وأما في الدين الإسلامي فإن المزايا فيه مبسوطة للجميع وليست حكراً على فئة خاصّة، فلا فرق بين العامّة والخاصّة والرجل والمرأة والأبيض والأسود، كلّهم متساوون من الناحية الفكرية في نظر الإسلام، ولهم الحق في تحصيل المزايا الدينية من غير تمييز أحد على آخر؛ قال تعالى: )أنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ((240).
استناداً إلى معطيات هذه المقدّمات الثلاث نرى أن القرآن الكريم ينظر في تعاليمه القيّمة، إلى الإنسانية بما هي إنسانية، أي أنه يوسّع تعاليمه على الإنسان باعتباره قابلاً للتربية والسير في مدارج الكمال.
وحيث إن الإفهام والعقول ذات مستويات متفاوتة في إدراك المعنويات ولا يؤمَن الخطر عند إلقاء المعارف العالية كما تقدّم، نرى القرآن يستعرض تعاليمه بأبسط المستويات التي تناسب العامّة، ويتكلّم في حدود فهمهم وداخل دائرة مداركهم الساذجة.
وهذه الطريقة الحكيمة سوف تنتج بثّ المعارف العالية من خلال اللغة التي يفهمها عامّة الناس، وتقوم ظواهر الألفاظ من خلال هذه الطريقة بعملية الإلقاء بشكل محسوس أو ما يقرب منه، وتبقى الحقائق المعنوية خلف ستار الظواهر وتتجلى حسب الأفهام، وينهل منها كلّ شخص بما له من قوة العقل والإدراك؛ يقول تعالى: )إنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٭ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ((241). ويقول ممثّلاً للحق والباطل ومقدار الأفهام: )أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها((242). ويقول النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله: «إنّا معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم»(243).
بل يمكن القول إن ثمّة نتيجة أخرى لهذه الطريقة في إلقاء المعارف والعلوم وهي كون ظواهر الآيات أمثالاً بالنسبة إلى بواطنها، أي المعارف الإلهية التي هي أعلى مستوى من أفهام العامّة، فتكون تلك الظواهر أمثالاً تقرّب المعارف المستورة إلى الإفهام؛ قال تعالى: )وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأبى أكْثَرُ النَّاسِ إلاَّ كُفُوراً((244). وقال أيضاً: )وَتِلْكَ الأمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إلاَّ الْعالِمُونَ((245).
وفي القرآن الكريم كثير من الأمثال، إلاّ أن الآيات المذكورة وما في معناها مطلقة لا تختصّ بأمثال قرآنية خاصّة، وعليه لابدّ من القول بأن الآيات كلّها أمثال بالنسبة إلى المعارف العالية التي هي المقصد الأسمى للقرآن.(246)
وبذلك يكون القرآن خارجاً عن قدرة البشر تكويناً، وأنّى للإنسان القاصر والمحدود بقواه المتغيّرة والمتبدّلة أن يأتي بكتاب يدوّن فيه مراتب الواقع العيني على ما هي عليه من النظام البديع والنظم التكويني الرائع؟! فتبارك الله أحسن الخالقين.
)بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ٭ فِي لَوْح مَحْفُوظٍ((247)
مصادر البحث
(240) آل عمران: 195.
(241) الزخرف: 3 ـ 4.
(242) الرعد: 17.
(243) راجع بحار الأنوار: ج1 ص37.
(244) الإسراء: 89.
(245) العنكبوت: 43.
(246) راجع:القرآن في الإسلام، السيد محمدحسين الطباطبائي، ترجمةالسيد أحمدالحسيني ص41 نشر مركز إعلام الذكرى الخامسة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران 1404هـ.
(247) البروج: 21 - 22 .





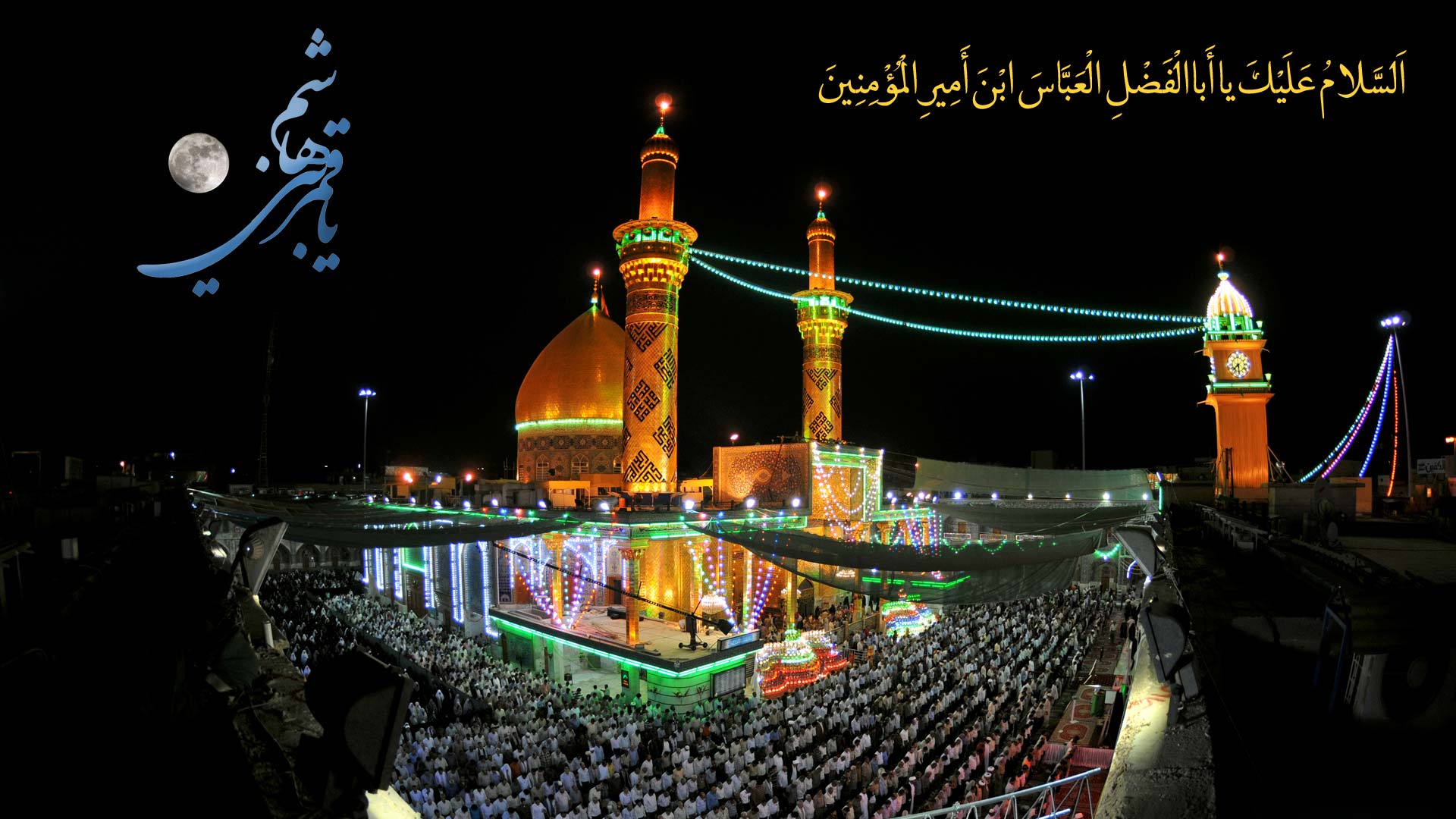





تعليق