من الأمور المهمة التنبيه إليها هو ما كثر الكلام فيه عند الشعراء وبعض الكتاب و على مواقع الانترنيت وفي كلامات بعض الخطباء وعامة الناس لفظ ( راهب) يطلقها على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) هذا اللفظ من الأخطاء الشائعة ومن الضروري تركه، أن الله نهى عن ( الرهبنة في الإسلام) وان الإسلام لا يحب هذا النمط من العبادة وهذه النوعية من الترهب والرهبنة بل الحكمة تقول ( خير الأمور أواسطها) أي أن الوسطية هي خير طرق للعبادة فنحن ومهما بلغنا من العبادة والأنس بالله سبحانه لن نكون أفضل حالاً من الأئمة (عليهم السلام) الذين عاشروا الناس ولم تكن معاشرتهم للناس قد أثرت بهم سلباً عن معاشرة الخالق حيث أنهم يتقوون بالحب الألهي لنصح الخلق فهذا هو مصدر طاقات أسرار علمهم وحكمهم (عليهم السلام) أليس من الضروري أن نتخذهم نحن قدوة لنا فالعبادة ليست بكثرة الصلاة والصيام أنما العباده بكثرة التفكر والتدبر والنصح للمؤمنين والقيام بالتكاليف الألهيه و لنا أسوة برسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) و بأهل البيت (عليهم السلام), نحتذي حذوهم ونمشي على أثارهم، فنرى كيف عاش الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) بين المسلمين,وكيف كانت طريقة أهل البيت (عليهم السلام) مع الناس. فهؤلاء أئمتنا وقدوتنا,وامتدادهم في زماننا هذا, زمن الغيبة الكبرى ,هم فقهاؤنا المجاهدين وعلماؤنا ا الكرام ومربينا الأفاضل .فلنقرأ سيرة هؤلاء القادة العظام ونتزود منهم لما يعيننا في طريقنا إلى الله تعالى. وحسب فهمي القاصر وما سمعته و قرأته عنهم (عليهم السلام) ان لا رهبانية في الإسلام) الإسلام دين العمل والحياة والمعاشرة والمشاركة في المجتمع وتحمل أذى الآخرين وهذا واضح في القضية الحسينية الخالدة .وكما يقول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) ان الدين النصيحة وان الدين المعاملة.ولعل تطبيق هذا الجانب العملي للدين هو أيضا من التوفيقات الكبرى للعبد .ونرى القران الكريم يؤكد على ذلك ونادرا ما نقرأ آية من القران الكريم يمدح الذين امنوا إلا مقرونة بعمل الصالحات وهي كثيرة جدا هذه الأعمال, ومن هذه الصالحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد في سبيل الله بالأموال والانفس، وكان أمير المؤمن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعمل بيده في الأرض لإحيائها ويشرف بنفسه على الضيعة لإصلاحها وصيانتها. يروى عن محمد بن المنكدر وهو من أقطاب الصوفية في عصر الإمام الباقر (سلام الله عليه) أنه قال: ما كنت أرى مثل علي بن الحسين (سلام الله عليهما) يدع خلفاً، لفضل علي بن الحسين (سلام الله عليهما) حتى رأيت ابنه محمد بن علي فأردت أنه أعظه فوعظني فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك؟
قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي (سلام الله عليهما) وكان رجلاً بديناً وهو متكيء على غلامين له أسودين أو موليين له، فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لأعظنّه، فدنوت منه فسلّمت عليه فسلّم عليّ بنهر وقد تصبب عرقاً.
فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال، قال: فخلّي عن الغلامين من يده ثم تساند وقال: لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكفّ بها نفسي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني.
إن الإمام الباقر (سلام الله عليه) قال لإبن المنكدر ذلك لأن الصوفية يرون العبادة في الصلاة والصوم والذكر والرياضات الروحية مع ترك العمل والكسب والأشغال الدنيوية الأخرى فهم عالة على المجتمع يأكلون ولا يعملون، ويأخذون منه ولا يعطون. وفي ذلك قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس منّا من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه).
فكان الإمام الباقر سلام الله عليه يحث شيعته على العمل المثمر والكسب الحلال والسعي المشروع في تحصيل المال ويقول لهم تسعة أعشار العبادة في الكسب الحلال).
ولنتعرف أكثر على المعنى الصحيح للبدعة، نرجع إلى القران الكريم، الذي إليه يرد علم الدين كله ونستوحي منه تغير كلمة البدعة وحكمها والآية الوحيدة التي بينت بصراحة حرمة البدعة (بهذا النص) هي الآية التالية: (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد:27. وهذه البدعة تتصل بتحريم النصارى على أنفسهم أكثر الطيبات باسم الدين والتي نفاها الإسلام بصراحة وقد روي النبي( صلى الله عليه واله وسلم) عنها حين قال لا رهبانية في الإسلام) وقال (صلى الله عليه واله وسلم) (رهبانية أمتي الجهاد).
ويبدو ان كلمة البدعة من الناحية اللغوية تطلق على الإضافة وليس على النقصان، ولكن إضافة منسوبة إلى الدين، تأمل في الحديث الشريف اذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله) .وفي الحديث وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع و الزموا المهيع، ان عوازم الأمور أفضلها و ان محدثاتها شرارها). وفي حديث أيضا إياك ان تستن سنة بدعة، فان العبد اذا سن سنة سيئة لحقه وزرها ووزر من عمل بها). فالذي يظهر من هذه الأحاديث ان البدعة إضافة إلى الدين، ولا ريب ان تحريم شيء أو إيجاب شيء، يعتبر زيادة في الدين، و يلحق بالبدعة.
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في بيان معنى كلمة البدعة، التي وردت في الأحاديث: البدعة كل رأي، أو دين، أو حكم أو عبادة، لم يرد (نص) من الشارع بخصوصها ولا في ضمن حكم عام.
ويقول شيخنا مرتضى المطهري (رحمه الله): (الزهد في اللغة ترك الشيء والرغبة عنه. وفي الاصطلاح يطلق على ترك الإنسان لشيء يرغب فيه رغبة طبيعية. أي إنّ صفة الزاهد لا تطلق على المريض الراغب عن تناول الطعام ولا على العنّين الراغب عن اللذة الجنسية .
الزهد من المفاهيم الإسلامية السامية البناءة التي انحرفت في أذهان المسلمين، ولعل الانحراف في مفهوم الزهد سرى إلى المسلمين من المسيحية. فالمسيحية فرّقت بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، واعتبرت كل ممارسة عملية للإنسان مع الطبيعة والحياة عملاً دنيوياً، بينما أطلقت على الطقوس المعزولة عن كل ممارسة حياتية اسم العمل الأخروي أو العبادة. وهاهو كتاب (المنجد) بين أيدينا يعبّر عن هذه النظرة المسيحيّة إذ يقول: زَهَد في الدنيا، أي تخلّى عنها للعبادة. وتزهّدَ: ترَكَ الدنيا للعبادة.
هذا المفهوم المنحرف عن الزهد ليس بجديد على المدرسة المسيحية، فقد ظهر فيها يوم ظهرت فيها الرهبانية التي قال عنها القرآن الكريم: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) والإسلام رفض هذه الرهبانية حين وصفها القرآن الكريم بأنها بدعة، وقال عنها رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم): (لا رهبانية في الإسلام). الإسلام يرفض أي انفصال بين العمل الدنيوي والأخروي، ويؤطر كل نشاطات الإنسان الحياتية بإطار ديني، ويعتبرها عبادة وعملاً أخروياً، إن كان فاعلها يبتغي منها رضا الله).
لما كان مبدأ الإسلام عمارة الأرض وإبلاغ النوع الإنساني كماله من الوجهتين المادية والمعنوية جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حاثاً على الزواج مشجعاً عليه ، بل عدّت فيه الرهبة من الأمور المحضورة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا رهبانية في الإسلام ) وقال: ( تناكحوا وتناسلوا فإني مباهٍ بكم الأُمم ).
وجاء في كتاب الحبر الأنبا غريغوريوس ( دير المحرق تاريخه ووصفه ) تحدث عن معنى كلمة راهب واشتقاقها اللغوي، وقد ذكر الآتي:
يقول المتنيح العلامة الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا الدير المحرق تاريخه ووصفه وكل مشتملاته , ألأنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمى إيداع رقم 4676/ 1992 ص26: ( لعل التعبير العربى (رُهْبان) هو جمع ( راهِب ) مشتق من الرٌهبْة أو الجزع الذى يتولى ذلك الطراز من عًباد الرب , عندما يدخل فى مرحلة فحص الضمير وإمتحان النفس ومعرفتها على حقيقتها خصوصاً عندما يصل إلى بعض الإشراق الباطنى ويشرف على مرحلة الشخوص فى الأنوار العليا فتتولاه الرهبة وجزع ) . والرهبة والجزع عبر عنها أشعياء النبى عندما وصل إلى لحظات الإشراق فقال : ( ويل لى إنى هلكت لأنى أنسان نجس الشفتين وأنا مقيم بين شعب نجس الشفتين , لأن عينى قد رأتا الملك ربٌ الجنود ( أشعياء 6: 5 ) وفى اللغة القبطية يقول الأنبا غريغوريوس : ( أن التعبير القبطى يستخدم للدلالة على كلمة راهب هو موناخوس ومنها أشتقت الكلمة اللاتينية Monachus والإنجليزية Monk والفرنسية moine وغيرها من اللغات الأخرى ) . وكل الكلمات فى اللغات السابقة معناها ( المتوحد) وذلك لأن المتوحد هو إنسان أعتزل الناس ليحيا بمفرده من غير زوجه وأولاد بعيداً عن المجتمع فيتوفر له الوقت الكافى لينموا با طنياً وروحياً ونفسياً والإنعزال عن المجتمع البشرى ليس أمراً سهلاً كما يبدو بل يمكن القول أنها مستحيله ولهذا قال أرسطو الفيلسوف لا يمكن لأحد من الناس أن يعيش بعيداً عن المجتمع إلا من كان دون الطبيعة البشرية أو فوق مستواها ) هذا كما يعبر الحبر الأنبا غريغوريوس.
وعندما نتعمق فى كلمات أرسطوا يتضح لنا الإتجاه الرهبانى فى الإنعزال والهدف ما أكده لنا تاريخ العلم الرهبانى:
1- إن هذه العزلة ممكنة لقلة متميزة من الناس , قد أرتفعت فوق السلوك البشرى في تصوراتهم, وسمت بمستواها فوق سلوك الغريزة البشرية , لنوال النعمة الإلهية الكاملة وهنا يتحقق قول أرسطو هو أن هذه المجموعة هى فوق مستوى الطبيعة البشرية لقلت سالكيها وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه عباده حيث نهى عن هذه العزلة.
2- والعزلة ليست غاية إنما هى وسيلة ضمن فكرهم ومن ضمن وسائل عديدة للرهبان لبلوغهم الهدف , هذا الهدف هو بلوغ المستويات الروحية والعلمية فى القداسة والنعمة كما يتوهم البعض. وقد أمر الإسلام خلاف هذه النقطة وهذه من شبهات العقل البشري في سمو الروح ونيل القداسة، كما بينا في حديثنا .
وأخيرا أؤكد للجميع الابتعاد من أطلاق لفظ راهب على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) فسجن الإمام (عليه السلام) ليس رهبنة بل بفعل حكام الجور لعزله عن المجتمع، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع أحداً يلفظ (راهب) ينبه لكونها لا تمت لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) من صله .ونسألكم الدعاء .
السيد ناظم الصافي الموسوي
قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي (سلام الله عليهما) وكان رجلاً بديناً وهو متكيء على غلامين له أسودين أو موليين له، فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لأعظنّه، فدنوت منه فسلّمت عليه فسلّم عليّ بنهر وقد تصبب عرقاً.
فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال، قال: فخلّي عن الغلامين من يده ثم تساند وقال: لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكفّ بها نفسي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني.
إن الإمام الباقر (سلام الله عليه) قال لإبن المنكدر ذلك لأن الصوفية يرون العبادة في الصلاة والصوم والذكر والرياضات الروحية مع ترك العمل والكسب والأشغال الدنيوية الأخرى فهم عالة على المجتمع يأكلون ولا يعملون، ويأخذون منه ولا يعطون. وفي ذلك قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس منّا من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه).
فكان الإمام الباقر سلام الله عليه يحث شيعته على العمل المثمر والكسب الحلال والسعي المشروع في تحصيل المال ويقول لهم تسعة أعشار العبادة في الكسب الحلال).
ولنتعرف أكثر على المعنى الصحيح للبدعة، نرجع إلى القران الكريم، الذي إليه يرد علم الدين كله ونستوحي منه تغير كلمة البدعة وحكمها والآية الوحيدة التي بينت بصراحة حرمة البدعة (بهذا النص) هي الآية التالية: (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد:27. وهذه البدعة تتصل بتحريم النصارى على أنفسهم أكثر الطيبات باسم الدين والتي نفاها الإسلام بصراحة وقد روي النبي( صلى الله عليه واله وسلم) عنها حين قال لا رهبانية في الإسلام) وقال (صلى الله عليه واله وسلم) (رهبانية أمتي الجهاد).
ويبدو ان كلمة البدعة من الناحية اللغوية تطلق على الإضافة وليس على النقصان، ولكن إضافة منسوبة إلى الدين، تأمل في الحديث الشريف اذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله) .وفي الحديث وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع و الزموا المهيع، ان عوازم الأمور أفضلها و ان محدثاتها شرارها). وفي حديث أيضا إياك ان تستن سنة بدعة، فان العبد اذا سن سنة سيئة لحقه وزرها ووزر من عمل بها). فالذي يظهر من هذه الأحاديث ان البدعة إضافة إلى الدين، ولا ريب ان تحريم شيء أو إيجاب شيء، يعتبر زيادة في الدين، و يلحق بالبدعة.
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في بيان معنى كلمة البدعة، التي وردت في الأحاديث: البدعة كل رأي، أو دين، أو حكم أو عبادة، لم يرد (نص) من الشارع بخصوصها ولا في ضمن حكم عام.
ويقول شيخنا مرتضى المطهري (رحمه الله): (الزهد في اللغة ترك الشيء والرغبة عنه. وفي الاصطلاح يطلق على ترك الإنسان لشيء يرغب فيه رغبة طبيعية. أي إنّ صفة الزاهد لا تطلق على المريض الراغب عن تناول الطعام ولا على العنّين الراغب عن اللذة الجنسية .
الزهد من المفاهيم الإسلامية السامية البناءة التي انحرفت في أذهان المسلمين، ولعل الانحراف في مفهوم الزهد سرى إلى المسلمين من المسيحية. فالمسيحية فرّقت بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، واعتبرت كل ممارسة عملية للإنسان مع الطبيعة والحياة عملاً دنيوياً، بينما أطلقت على الطقوس المعزولة عن كل ممارسة حياتية اسم العمل الأخروي أو العبادة. وهاهو كتاب (المنجد) بين أيدينا يعبّر عن هذه النظرة المسيحيّة إذ يقول: زَهَد في الدنيا، أي تخلّى عنها للعبادة. وتزهّدَ: ترَكَ الدنيا للعبادة.
هذا المفهوم المنحرف عن الزهد ليس بجديد على المدرسة المسيحية، فقد ظهر فيها يوم ظهرت فيها الرهبانية التي قال عنها القرآن الكريم: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) والإسلام رفض هذه الرهبانية حين وصفها القرآن الكريم بأنها بدعة، وقال عنها رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم): (لا رهبانية في الإسلام). الإسلام يرفض أي انفصال بين العمل الدنيوي والأخروي، ويؤطر كل نشاطات الإنسان الحياتية بإطار ديني، ويعتبرها عبادة وعملاً أخروياً، إن كان فاعلها يبتغي منها رضا الله).
لما كان مبدأ الإسلام عمارة الأرض وإبلاغ النوع الإنساني كماله من الوجهتين المادية والمعنوية جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حاثاً على الزواج مشجعاً عليه ، بل عدّت فيه الرهبة من الأمور المحضورة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا رهبانية في الإسلام ) وقال: ( تناكحوا وتناسلوا فإني مباهٍ بكم الأُمم ).
وجاء في كتاب الحبر الأنبا غريغوريوس ( دير المحرق تاريخه ووصفه ) تحدث عن معنى كلمة راهب واشتقاقها اللغوي، وقد ذكر الآتي:
يقول المتنيح العلامة الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا الدير المحرق تاريخه ووصفه وكل مشتملاته , ألأنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمى إيداع رقم 4676/ 1992 ص26: ( لعل التعبير العربى (رُهْبان) هو جمع ( راهِب ) مشتق من الرٌهبْة أو الجزع الذى يتولى ذلك الطراز من عًباد الرب , عندما يدخل فى مرحلة فحص الضمير وإمتحان النفس ومعرفتها على حقيقتها خصوصاً عندما يصل إلى بعض الإشراق الباطنى ويشرف على مرحلة الشخوص فى الأنوار العليا فتتولاه الرهبة وجزع ) . والرهبة والجزع عبر عنها أشعياء النبى عندما وصل إلى لحظات الإشراق فقال : ( ويل لى إنى هلكت لأنى أنسان نجس الشفتين وأنا مقيم بين شعب نجس الشفتين , لأن عينى قد رأتا الملك ربٌ الجنود ( أشعياء 6: 5 ) وفى اللغة القبطية يقول الأنبا غريغوريوس : ( أن التعبير القبطى يستخدم للدلالة على كلمة راهب هو موناخوس ومنها أشتقت الكلمة اللاتينية Monachus والإنجليزية Monk والفرنسية moine وغيرها من اللغات الأخرى ) . وكل الكلمات فى اللغات السابقة معناها ( المتوحد) وذلك لأن المتوحد هو إنسان أعتزل الناس ليحيا بمفرده من غير زوجه وأولاد بعيداً عن المجتمع فيتوفر له الوقت الكافى لينموا با طنياً وروحياً ونفسياً والإنعزال عن المجتمع البشرى ليس أمراً سهلاً كما يبدو بل يمكن القول أنها مستحيله ولهذا قال أرسطو الفيلسوف لا يمكن لأحد من الناس أن يعيش بعيداً عن المجتمع إلا من كان دون الطبيعة البشرية أو فوق مستواها ) هذا كما يعبر الحبر الأنبا غريغوريوس.
وعندما نتعمق فى كلمات أرسطوا يتضح لنا الإتجاه الرهبانى فى الإنعزال والهدف ما أكده لنا تاريخ العلم الرهبانى:
1- إن هذه العزلة ممكنة لقلة متميزة من الناس , قد أرتفعت فوق السلوك البشرى في تصوراتهم, وسمت بمستواها فوق سلوك الغريزة البشرية , لنوال النعمة الإلهية الكاملة وهنا يتحقق قول أرسطو هو أن هذه المجموعة هى فوق مستوى الطبيعة البشرية لقلت سالكيها وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه عباده حيث نهى عن هذه العزلة.
2- والعزلة ليست غاية إنما هى وسيلة ضمن فكرهم ومن ضمن وسائل عديدة للرهبان لبلوغهم الهدف , هذا الهدف هو بلوغ المستويات الروحية والعلمية فى القداسة والنعمة كما يتوهم البعض. وقد أمر الإسلام خلاف هذه النقطة وهذه من شبهات العقل البشري في سمو الروح ونيل القداسة، كما بينا في حديثنا .
وأخيرا أؤكد للجميع الابتعاد من أطلاق لفظ راهب على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) فسجن الإمام (عليه السلام) ليس رهبنة بل بفعل حكام الجور لعزله عن المجتمع، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع أحداً يلفظ (راهب) ينبه لكونها لا تمت لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) من صله .ونسألكم الدعاء .
السيد ناظم الصافي الموسوي







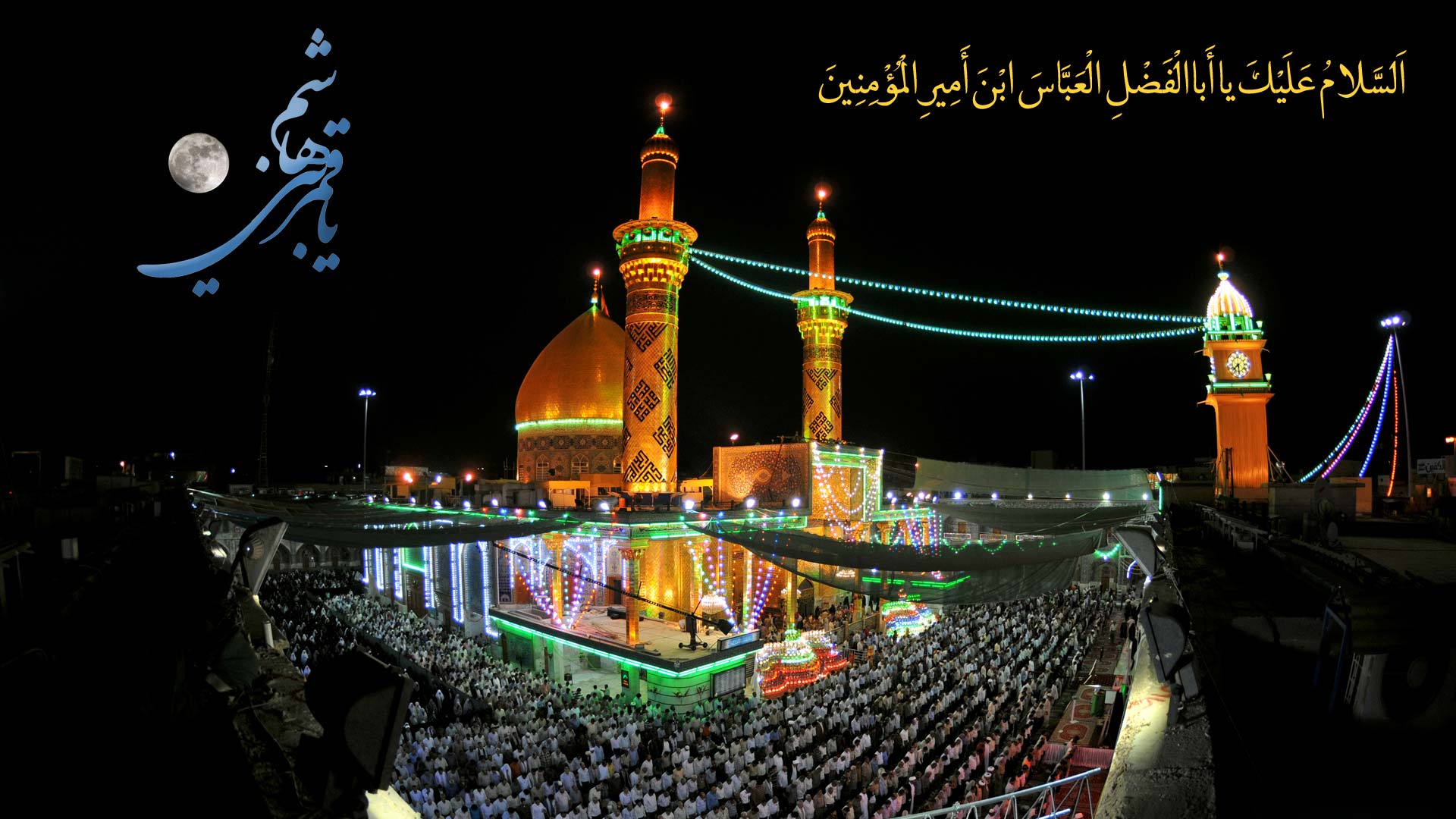
تعليق