شخصيتنا العاملية لهذا اليوم
العلامة الشاعر الشيخ عبد الحسين صادق

ولد في النجف، والده الشيخ إبراهيم صادق إمام بلدة الخيام توفيت والدته وهو ابن أشهر قليلة وبعد خمس سنوات توفي والده فعاش يتيماً في منزل الحاج محمد عبد الله زوج شقيقته الكبرى خاشية صادق.
غادر الخيام وهو بعد صبياً إلى النجف حيث التحق بالحوزات العلمية ودرس الفقه والأصول وسائر العلوم الدينية على كبار المراجع إلى أن نال منهم إجازات الاجتهاد، وعاد إلى موطنه جبل عامل واستقر في الخيام بعد ستة عشر عاماً مدرِّساً في حوزاته ومبرِّزاً في ميدان الشعر والأدب إلى جانب زعامة دينية ومكانة سياسية واجتماعية جعلته في مصاف عمالقة جبل عامل في ذلك الزمان وعنيت بهم السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد محسن الأمين وابن عمه السيد حسن محمود والسيد نجيب فضل الله والشيخ مهدي شمس الدين والسيد عبد الحسين نور الدين وغيرهم.
وكان الحظ أسعف الشيخ في ذلك الزمان نهاية القرن التاسع عشر بافتتاح المدرسة الحميدية التي أسسها العلامة السيد حسن يوسف وخرجت أعلام النهضة العاملية آنذاك وهم الشيخ أحمد عارف الزين والشيخ سليمان ظاهر والشيخ أحمد رضا والأستاذ محمد جابر آل صفا الذين زخرت بهم النبطية وجوارها موطن شيخنا وشاعرنا الجليل الشيخ عبد الحسين صادق، الذي انضم إلى هذا السرب النهضوي وقام يصدح بينهم شاعراً ويكتب مرشداً ومفقها في مجلة العرفان وغيرها من المنشورات التي بدأت تصدر مطلع القرن العشرين.
ولما توفي الشيخ حسن يوسف تولى الشيخ صادق إدارة المدرسة الحميدية في النبطية، ثم أسس أوّل حسينية في جبل عامل وهي حسينية النبطية عام 1909 وجعلها منبراً لمجالس العزاء الحسيني وللمناسبات الدينية والوطنية والقومية. ومن مآثره السياسية أنه انتدب من قبل أعيان جبل عامل لمبايعة الأمير فيصل والحكومة العربية في دمشق في 15 أيار 1919 ووقف أمام الأمير قائلاً كلمته المشهورة: «إنني باسم أهل جبل عامل أبايعك على الموت». مظهراً بذلك الروح العربية الأصيلة التي كانت تنادي آنذاك بوحدة سوريا العربية بزعامة الأمير فيصل واستقلالها عن الفرنسي المحتل.
ترك عقب وفاته عام 1942 مجموعة من المؤلفات الفقهية والأدبية ودواوين شعرية نختار منها ما اعتدنا أن نختاره من شعر طريف لطيف يحاكي الزمن البكر الذي أنجب العلامة الشيخ عبد الحسين صادق الأستاذ والفقيه والشاعر المجلّي.
ففي قوله لأحدهم بعد أن طرح العمّة العربية ولبس الثياب العصرية وكان هذا العمل قديماً يعدُّ مستهجناً يعيب صاحبه:
تأفندت يا ابن الخير في من تأفندا00متمرِّدا إن شئت أن تتمرّدا
وكن من بني الطربوش كشفاً (مموعصا) 00 ولا تتعمَّم قط إن تسحب الرَّدا
لقد ضللتم عصبة أمركيّّة 00 لها المال منقاد عقار وعسجدا
فما نلت من دنياك عيشاً مرفهاً 00ولا نلت في أخراك خيراً مؤبَّدا
وهذان بيتا شعر يدين الشاعر أحد المتردّدين عليه وقد حلق لحيته وكان يعدّ أيضاً هذا العمل من الكبائر في ذلك الزمان:
عجباً لشبان تقصّ لحاها 00 الله أكبر ما أقلّ حياها
لم يبق منها يا محمد شعرة 00 إلاّ وبرّاء الحديد براها
المحامي وحاكم الصلح
وفي نقد لعمل المحاكم المدنيّة وقضاتها ومحاميها هذه القصيدة:
يا حاكم الصلح عجل 00 لنا لفصل القضاء
كما مات إنسان حق 00 في عَلَّه الإنساء
لو كان ذو الحق «نوحا» 00 لمات قبل لقائه!
أو مات أيوب صبراً 00 لملَّ طول بقائه
من المحامين فذٌّ 00 لم يدرس الفقه إلاّ
ليجعل الحلَّ حرماً 00 ويجعل الحرم حلاَّ!
يأتي المحاكم صبحاً 00 وقد تأبَّط شرّا!
أسطورة رقّمتها 00 الأهواء سطراً فسطرا
وفي نقده للصحافة التي لا همّ لها سوى رضى الحاكم المستبدّ:
صحافة الصحاف في عصرنا 00 سياسة للحاكم المستطيل
وجود ما يرضى به لازم 00 فيها، وما يكرهه مستحيل
أليس ذا عذراً جميلاً لمن 00 فرَّ عن الصحاف آلاف ميل!
عمَّ الفساد
وفي قصيدة رائعة يصف الواقع الاجتماعي المتردّي في زمانه وهو أشبه بواقع اليوم منه بالأمس:
بدعٌ تشب فتلهب المحن 00 وهوًى يهبُّ فتطفأ السنن
وثلاثة غمر البسيط بها 00 فتنٌ وفتّانٌ، ومفتن
والناس لا ناس فيحفظهم 00 ما أنكرته العين والأذن
بإسم التمدّن أرعدت فخوت 00 منها قرى الإيمان والمدن
فانحط أعلاها لأسفلها 00 فتساوت الأوهاد والقنن
تدعو لعلمٍ أو إلى وطن 00 والقصد لا علم ولا وطن
القوم سرّهم معاوية 00 وقميص عثمان لهم علن
هم من ورا أكماته رقش 00 أنيابها الأقلام واللسن
مهما دعوا لضلالة سلسوا 00 وإلى الهداية إن دعوا حزنوا
يتلوَّنون لكلّ آونة 00 لوناً يناسب صبغة الزّمن
جاء في مذكرات العلامة الشيخ حبيب آل إبراهيم واصفاً استقبال الأمير فيصل في بيروت لدى عودته من أوروبا في 30 نيسان 1919، ما يلي: «استحسن جمع من علماء جبل عامل استقباله والاجتماع به في بيروت.. ولما خرج الأمير فيصل من الدارعة الحاملة له إلى المحل المعدّ لاستقراره (قصر عمر الداعوق – رئيس بلدية بيروت) أقبلت وجوه الناس للسلام عليه مترتبين، تدخل من باب وتخرج من آخر، لضيق المكان عن وسع تلك الوفود. ولما أُدخلنا عليه أنشده الزعيم الجليل الشيخ عبد الحسين صادق:
لو جاز سعْيُ الأرض 00 تعْظيماً إلى استقبال مولى
لسعت إليك بلادنا 00 عزّا وإجلالاً وطوْلا
وجرت بمضْمارِ السِّباقِ 00 و«عاملٌ» بالسَّبقِ أوْلى
ولَعَمري أنّه أجادَ كل الإجادة وأبدع كل الإبداع
أما لماذا ارتجل الشيخ عبد الحسين صادق هذه الأبيات المتضمنة إشارة ذات معنى يفهمها اللبيب، فلِكون المسؤول عن تنظيم دخول الوفود، من شتى المناطق، على الأمير فيصل، في مضيفه البيروتي، قد تعمّد، لسب مجهول، تأخير إدخال الوفد العاملي ما أغضب الشيخ الشاعر وحمله على ارتجال هذه الأبيات التي أدرك معناها الأمير فوراً فأظهر ترحيباً خاصاً بالوفد العاملي ودعاه إلى الذهاب معه إلى الشام.
العلامة الشاعر الشيخ عبد الحسين صادق

ولد في النجف، والده الشيخ إبراهيم صادق إمام بلدة الخيام توفيت والدته وهو ابن أشهر قليلة وبعد خمس سنوات توفي والده فعاش يتيماً في منزل الحاج محمد عبد الله زوج شقيقته الكبرى خاشية صادق.
غادر الخيام وهو بعد صبياً إلى النجف حيث التحق بالحوزات العلمية ودرس الفقه والأصول وسائر العلوم الدينية على كبار المراجع إلى أن نال منهم إجازات الاجتهاد، وعاد إلى موطنه جبل عامل واستقر في الخيام بعد ستة عشر عاماً مدرِّساً في حوزاته ومبرِّزاً في ميدان الشعر والأدب إلى جانب زعامة دينية ومكانة سياسية واجتماعية جعلته في مصاف عمالقة جبل عامل في ذلك الزمان وعنيت بهم السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد محسن الأمين وابن عمه السيد حسن محمود والسيد نجيب فضل الله والشيخ مهدي شمس الدين والسيد عبد الحسين نور الدين وغيرهم.
وكان الحظ أسعف الشيخ في ذلك الزمان نهاية القرن التاسع عشر بافتتاح المدرسة الحميدية التي أسسها العلامة السيد حسن يوسف وخرجت أعلام النهضة العاملية آنذاك وهم الشيخ أحمد عارف الزين والشيخ سليمان ظاهر والشيخ أحمد رضا والأستاذ محمد جابر آل صفا الذين زخرت بهم النبطية وجوارها موطن شيخنا وشاعرنا الجليل الشيخ عبد الحسين صادق، الذي انضم إلى هذا السرب النهضوي وقام يصدح بينهم شاعراً ويكتب مرشداً ومفقها في مجلة العرفان وغيرها من المنشورات التي بدأت تصدر مطلع القرن العشرين.
ولما توفي الشيخ حسن يوسف تولى الشيخ صادق إدارة المدرسة الحميدية في النبطية، ثم أسس أوّل حسينية في جبل عامل وهي حسينية النبطية عام 1909 وجعلها منبراً لمجالس العزاء الحسيني وللمناسبات الدينية والوطنية والقومية. ومن مآثره السياسية أنه انتدب من قبل أعيان جبل عامل لمبايعة الأمير فيصل والحكومة العربية في دمشق في 15 أيار 1919 ووقف أمام الأمير قائلاً كلمته المشهورة: «إنني باسم أهل جبل عامل أبايعك على الموت». مظهراً بذلك الروح العربية الأصيلة التي كانت تنادي آنذاك بوحدة سوريا العربية بزعامة الأمير فيصل واستقلالها عن الفرنسي المحتل.
ترك عقب وفاته عام 1942 مجموعة من المؤلفات الفقهية والأدبية ودواوين شعرية نختار منها ما اعتدنا أن نختاره من شعر طريف لطيف يحاكي الزمن البكر الذي أنجب العلامة الشيخ عبد الحسين صادق الأستاذ والفقيه والشاعر المجلّي.
ففي قوله لأحدهم بعد أن طرح العمّة العربية ولبس الثياب العصرية وكان هذا العمل قديماً يعدُّ مستهجناً يعيب صاحبه:
تأفندت يا ابن الخير في من تأفندا00متمرِّدا إن شئت أن تتمرّدا
وكن من بني الطربوش كشفاً (مموعصا) 00 ولا تتعمَّم قط إن تسحب الرَّدا
لقد ضللتم عصبة أمركيّّة 00 لها المال منقاد عقار وعسجدا
فما نلت من دنياك عيشاً مرفهاً 00ولا نلت في أخراك خيراً مؤبَّدا
وهذان بيتا شعر يدين الشاعر أحد المتردّدين عليه وقد حلق لحيته وكان يعدّ أيضاً هذا العمل من الكبائر في ذلك الزمان:
عجباً لشبان تقصّ لحاها 00 الله أكبر ما أقلّ حياها
لم يبق منها يا محمد شعرة 00 إلاّ وبرّاء الحديد براها
المحامي وحاكم الصلح
وفي نقد لعمل المحاكم المدنيّة وقضاتها ومحاميها هذه القصيدة:
يا حاكم الصلح عجل 00 لنا لفصل القضاء
كما مات إنسان حق 00 في عَلَّه الإنساء
لو كان ذو الحق «نوحا» 00 لمات قبل لقائه!
أو مات أيوب صبراً 00 لملَّ طول بقائه
من المحامين فذٌّ 00 لم يدرس الفقه إلاّ
ليجعل الحلَّ حرماً 00 ويجعل الحرم حلاَّ!
يأتي المحاكم صبحاً 00 وقد تأبَّط شرّا!
أسطورة رقّمتها 00 الأهواء سطراً فسطرا
وفي نقده للصحافة التي لا همّ لها سوى رضى الحاكم المستبدّ:
صحافة الصحاف في عصرنا 00 سياسة للحاكم المستطيل
وجود ما يرضى به لازم 00 فيها، وما يكرهه مستحيل
أليس ذا عذراً جميلاً لمن 00 فرَّ عن الصحاف آلاف ميل!
عمَّ الفساد
وفي قصيدة رائعة يصف الواقع الاجتماعي المتردّي في زمانه وهو أشبه بواقع اليوم منه بالأمس:
بدعٌ تشب فتلهب المحن 00 وهوًى يهبُّ فتطفأ السنن
وثلاثة غمر البسيط بها 00 فتنٌ وفتّانٌ، ومفتن
والناس لا ناس فيحفظهم 00 ما أنكرته العين والأذن
بإسم التمدّن أرعدت فخوت 00 منها قرى الإيمان والمدن
فانحط أعلاها لأسفلها 00 فتساوت الأوهاد والقنن
تدعو لعلمٍ أو إلى وطن 00 والقصد لا علم ولا وطن
القوم سرّهم معاوية 00 وقميص عثمان لهم علن
هم من ورا أكماته رقش 00 أنيابها الأقلام واللسن
مهما دعوا لضلالة سلسوا 00 وإلى الهداية إن دعوا حزنوا
يتلوَّنون لكلّ آونة 00 لوناً يناسب صبغة الزّمن
جاء في مذكرات العلامة الشيخ حبيب آل إبراهيم واصفاً استقبال الأمير فيصل في بيروت لدى عودته من أوروبا في 30 نيسان 1919، ما يلي: «استحسن جمع من علماء جبل عامل استقباله والاجتماع به في بيروت.. ولما خرج الأمير فيصل من الدارعة الحاملة له إلى المحل المعدّ لاستقراره (قصر عمر الداعوق – رئيس بلدية بيروت) أقبلت وجوه الناس للسلام عليه مترتبين، تدخل من باب وتخرج من آخر، لضيق المكان عن وسع تلك الوفود. ولما أُدخلنا عليه أنشده الزعيم الجليل الشيخ عبد الحسين صادق:
لو جاز سعْيُ الأرض 00 تعْظيماً إلى استقبال مولى
لسعت إليك بلادنا 00 عزّا وإجلالاً وطوْلا
وجرت بمضْمارِ السِّباقِ 00 و«عاملٌ» بالسَّبقِ أوْلى
ولَعَمري أنّه أجادَ كل الإجادة وأبدع كل الإبداع
أما لماذا ارتجل الشيخ عبد الحسين صادق هذه الأبيات المتضمنة إشارة ذات معنى يفهمها اللبيب، فلِكون المسؤول عن تنظيم دخول الوفود، من شتى المناطق، على الأمير فيصل، في مضيفه البيروتي، قد تعمّد، لسب مجهول، تأخير إدخال الوفد العاملي ما أغضب الشيخ الشاعر وحمله على ارتجال هذه الأبيات التي أدرك معناها الأمير فوراً فأظهر ترحيباً خاصاً بالوفد العاملي ودعاه إلى الذهاب معه إلى الشام.
30













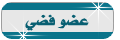

تعليق